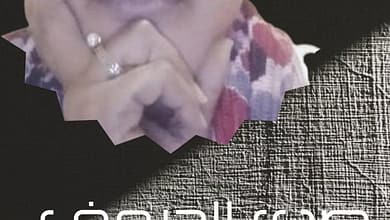في خضم الجدل الدائر حول احتكار تصدير الذهب، تبرز الحاجة إلى تفكيك الخطاب السائد الذي يبسط المسألة إلى مجرد تنظيم إداري أو ضبط لسوق مضطرب. والحقيقة أن القضية أعمق من ذلك بكثير، فهي تمس جوهر تخصيص الموارد، وعدالة التوزيع، وكفاءة السوق، في ظل اقتصاد ريعي هش، تتداخل فيه المصالح وتغيب فيه الرؤية المؤسسية المتوازنة.
أولاً: هيكل الإنتاج وتحصيل الإيرادات الحكومية
ينقسم إنتاج الذهب في السودان إلى قطاعين رئيسيين:
– التعدين الأهلي: يُنتج ما يقارب 75% من إجمالي الذهب، ويعتمد على أدوات تقليدية، لكنه يفتقر إلى آليات رقابية فعالة، مما يجعله عرضة للتهريب، ويُضعف قدرة الدولة على تحصيل العائدات بشكل منظم وهو منتشر في بقاع السودان.
– التعدين المنظّم عبر الشركات: يُمثل نحو 25% من الإنتاج، ويخضع لنظام ضريبي أكثر وضوحاً، وهو الجهات المسموح لها بالتصدير الرسمي.
الإيرادات الحكومية من القطاع الأهلي تُحصل عبر رسوم على عمليات النقل الكرته والمعالجة، والتصاديق لمربعات التعدين بينما تلزم الشركات بتسليم نسب من الإنتاج للدولة. وقد خُفضت هذه النسب مؤخراً من 27% إلى 20%، في حالات الكرتة ثم إلى 17% في حالات المعالجة اخري ، كما خُفضت ضريبة أرباح الأعمال من 30% إلى 15%، في محاولة لتحفيز الالتزام بالقنوات الرسمية.
ورغم إدخال تطبيق إلكتروني حكومي لتنظيم العمليات، إلا أن ضعف البنية التقنية، وغياب الحوافز السعرية، وانعدام الثقة في النظام المصرفي، قلص من فعاليته، وجعل المنتجين أكثر ميلاً للتعامل خارج الإطار الرسمي.
ثانياً: منطق القرار الحكومي ومحدودية أثره
القرار باحتكار تصدير الذهب يستند إلى منطق مركزي يقوم على:
– توحيد جهة التصدير لضبط التدفقات النقدية.
– تقليص الفوضى وتحقيق استقرار سعر الصرف.
– تعزيز الشفافية عبر منصة رقمية قومية.
لكن هذا المنطق، وإن بدا تنظيمياً، يُغفل أن السوق لا يدار بالقرارات الإدارية وحدها، بل بمنظومة حوافز اقتصادية متكاملة، تشمل التسعير العادل، المرونة التشغيلية، والثقة المؤسسية. فغياب المنافسة، واحتكار جهة واحدة لعملية التصدير، يُفضي إلى تشوّه في آلية التسعير، ويُضعف ديناميكية السوق، ويُعزز التهريب كخيار عقلاني للمنتجين في ظل غياب الجدوى الاقتصادية من الالتزام الرسمي.
ثالثاً: التهريب كعرض اقتصادي لا كمخالفة قانونية
التهريب لا يُمكن اختزاله في كونه مخالفة قانونية، بل هو انعكاس مباشر لاختلال الحوافز داخل السوق. فعندما تُفرض ضرائب مرتفعة (تصل إلى 10% على التعدين الأهلي)، وتُلزم الشركات بتسليم نسب من الإنتاج دون مقابل عادل، وتُقدم الجهة الحكومية أسعاراً غير تنافسية، فإن المنتجين يتجهون تلقائياً إلى السوق السوداء، حيث الأسعار أعلى، والإجراءات أقل تعقيداً، والمخاطر محسوبة.
النتيجة: الذهب يُهرب إلى دول مجاورة، وعلى رأسها مصر، حيث يُشترى وفق سعر بورصة الذهب العالمية بأسعار عادلة “Fair” ومعقولة، بينما تفشل القنوات الرسمية في استقطاب المنتجين، رغم أنها الجهة الوحيدة المصرح لها بالتصدير.
رابعاً: الآثار الاقتصادية للاحتكار
– تعطيل آلية السوق: إقصاء الشركات المستقلة يضعف المنافسة ويُقلل من كفاءة تخصيص الموارد.
– تكرار التجارب الفاشلة: تجربة احتكار بنك السودان المركزي لتجارة الذهب سابقاً أدت إلى خسائر وتراجع في الصادرات.
– تعزيز التهريب: بدلاً من الحد منه، يُفاقم الاحتكار الظاهرة، خاصة في ظل ضعف الرقابة الميدانية واستحالة السيطرة على المنافذ الحدودية والانشار الواسع للتعدين الأهلي.
– أثر مالي سلبي: دخول الحكومة المباشر في عمليات الشراء يُعزز احتمالية الاستدانة من النظام المصرفي، مما يُعمّق العجز المالي؛ فكل جنيه يُستدان قد يؤدي إلى عجز مضاعف يصل إلى ثلاثة جنيهات، وفق قاعدة الانكماش النقدي المرتبط بسوء إدارة الموارد.
– تفاقم أزمة ميزان المدفوعات: الذهب يُمثل المورد الرئيسي للنقد الأجنبي بعد الحرب، واحتكاره دون آلية تسعير عادلة يُهدد بانكماش تدفقات العملة الصعبة، ويضعف قدرة الدولة على تمويل الواردات الاستراتيجية.
– فتح باب الفساد: تركيز النفوذ الاقتصادي في يد جهة واحدة يغذي الفساد ويُضعف الشفافية، كما حذرت شعبة مصدري الذهب من تكرار تجربة الإنقاذ الكارثية.
خامساُ: مقترحات لإعادة التوازن
– إعادة النظر في سياسة الاحتكار، وفتح المجال أمام شراكة مؤسسية بين القطاعين العام والخاص، تراعي كفاءة السوق وعدالة التوزيع.
– مراجعة النظام الضريبي بما يُحفّز الالتزام الرسمي دون إرهاق المنتجين، ويُقلل من التكاليف الحدية للإنتاج.
– اعتماد سياسة سعرية مرنة تراعي الأسعار العالمية، وتُغري المنتجين بالبيع عبر القنوات الرسمية.
– تحسين البنية التقنية وربطها بمنظومة مصرفية موثوقة تُعزز الثقة وتُقلل من التعاملات النقدية غير الرسمية.
– تبني سياسات نقدية متوازنة تُراعي أثر الاستدانة على التضخم والعجز المالي، وتُعزز الاستقرار الكلي.
سادساُ: تجارب دولية مقارنة
دول مثل غانا وتنزانيا واجهت تحديات مماثلة، ونجحت في تقليص التهريب عبر:
– سياسات تشاركية مع القطاع الخاص.
– تقديم أسعار شراء قريبة من السوق العالمية.
– تسهيلات مصرفية مرنة تُراعي واقع المنتجين.
هذه التجارب تُثبت أن الحل لا يكمن في الاحتكار، بل في بناء منظومة متوازنة تُراعي منطق السوق وتُعزز الثقة المؤسسية.
توصية استراتيجية إضافية
– إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع الذهب: تكون مسؤولة عن التسعير، الرقابة، والتصدير، وتضم ممثلين من القطاع الأهلي، الشركات، والجهات الحكومية، لضمان التوازن والشفافية، وتفادي تركيز القرار الاقتصادي في يد جهة واحدة.
– العمل علي أنشأة بورصة عالمية: يُعد إنشاء بورصة ذهب بمواصفات عالمية في السودان خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع وتعزيز الاقتصاد الوطني. فالبورصة توفر منصة رسمية لتداول الذهب بشفافية، وتُسهم في تقليل التهريب، وضمان تسعير عادل وفق السوق العالمية. كما تُحفز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتُعزز احتياطي النقد الأجنبي عبر قنوات تصدير رسمية. لإنجاح المشروع، يجب تأسيس هيئة مستقلة، وتطوير بنية تقنية متكاملة، وربط البورصة بالنظام المصرفي، مع اعتماد معايير دولية للتنقية والوزن. إشراك القطاع الأهلي والرسمي، وتقديم حوافز ضريبية، سيُسهم في بناء ثقة المنتجين، وتحويل الذهب من مورد غير منضبط إلى رافعة اقتصادية مستدامة.
هذه المداخلة لا تهدف إلى رفض القرار من حيث المبدأ، بل إلى إعادة صياغته ضمن رؤية اقتصادية تُراعي منطق السوق، وتُعزز الثقة المؤسسية، وتُعيد للذهب مكانته كمورد استراتيجي لا كمادة خام تدار بمنطق الجباية.