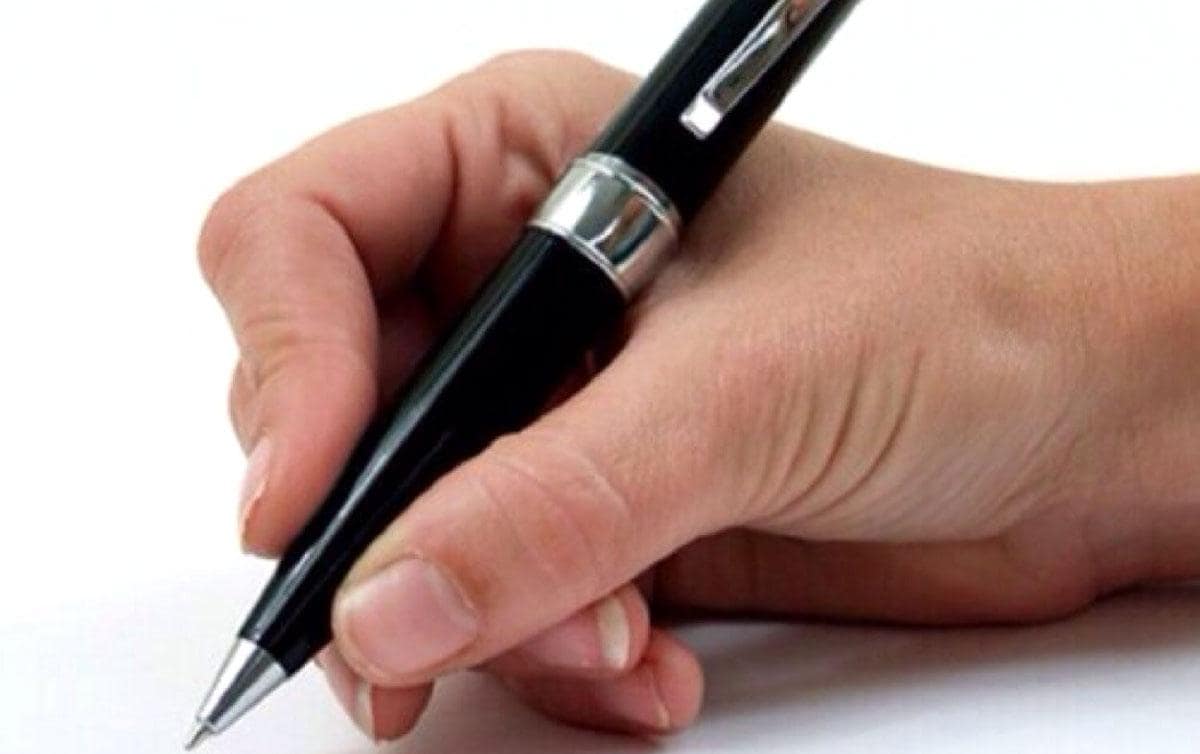موطئ قلم
أسامة محمد عبدالرحيم
عقيد بحري ركن متقاعد
دكتوراه في الدراسات الاستراتيجية (أمن البحر الأحمر)
إستراتيجية العلاقات الاقتصادية – الأمنية البحرية ومآلات أمن واقتصاد الدول المشاطئة للبحر الأحمر (2)
في الجزء الأول من هذا المقال، عرضنا الأسس النظرية للعلاقات الاقتصادية – الأمنية البحرية في البحر الأحمر، وحددنا الأبعاد الاقتصادية والأمنية التي تتقاطع في هذه المنطقة الحيوية، كما استعرضنا المحددات الرئيسة، والفرص المتاحة، والتحديات القائمة، وانتهينا إلى أن الدول الإفريقية المشاطئة، رغم امتلاكها أطول السواحل وأكثر الموارد، تبقى الأقل استفادة من موقعها الاستراتيجي بسبب غياب الرؤية التكاملية وضعف القدرات الوطنية.
لكن لفهم مآلات هذه المعادلة المركّبة لا يكفي التوقف عند التحليل العام؛ بل لابد من النظر في النماذج التطبيقية التي تجسد في الواقع هذا التداخل بين الأمن والاقتصاد. ومن بين هذه النماذج يبرز:
إسرائيل التي انتقلت من مرحلة حماية منفذها البحري الوحيد في إيلات إلى استخدام الاقتصاد والتكنولوجيا كأدوات نفوذ بحري وإقليمي.
مشروع “نيوم” السعودي الذي يعكس تحوّلًا استراتيجيًا في استثمار البحر الأحمر، جامعًا بين الطموحات التنموية والأبعاد الأمنية والجيوسياسية.
إن دراسة هذين النموذجين تتيح لنا قراءة أعمق لديناميات البحر الأحمر، و تكشف عن التحولات الإقليمية العميقة، كما تساعد ايضاً على قراءة انعكاساتها المباشرة على السودان و كافة الدول الافريقية المشاطئة ، وتساعد على استشراف انعكاساتهما على السودان والدول الإفريقية المشاطئة، وتحديد و رسم ملامح البدائل الإستراتيجية الممكنة أمامهاو التي تحفظ لهذه الدول مكانتها و دورها.
إسرائيل والبحر الأحمر – من الأمن إلى الاقتصاد
منذ نشأتها، نظرت إسرائيل إلى البحر الأحمر باعتباره “شريانًا استراتيجيًا حيويًا” يربطها بالمحيط الهندي والعالم الآسيوي والإفريقي. ويُمثل ميناء إيلات المنفذ الوحيد لها على البحر الأحمر، وبالتالي كان ركيزة أساسية في حساباتها الأمنية والسياسية والاقتصادية. ويمكن فهم تطور إستراتيجيتها في البحر الأحمر عبر مرحلتين رئيسيتين:
أ. المرحلة الأولى: الأمن البحري كأولوية مطلقة:
حماية إيلات: قبل معاهدة السلام مع مصر عام 1979، كان هاجس إسرائيل الأكبر هو ضمان أمن إيلات وخطوط الملاحة المؤدية إليه، خاصة في ظل سيطرة مصر على مضيق تيران وخليج العقبة.
أحداث تاريخية مفصلية: إغلاق مضيق تيران أمام الملاحة الإسرائيلية عام 1967 كان أحد أبرز الأسباب المباشرة لاندلاع حرب يونيو (حرب الأيام الستة)، ما يوضح حساسية هذا الممر لإسرائيل.
بناء قوة بحرية: رغم صغر حجمها، ركزت البحرية الإسرائيلية على القدرات النوعية (زوارق الصواريخ، الغواصات، أنظمة المراقبة) لتعويض قلة الحجم، ولضمان الردع البحري وحماية خطوط التجارة.
التحالفات الأمنية: إسرائيل سعت منذ وقت مبكر إلى بناء قنوات اتصال سرية وغير مباشرة مع بعض الدول المشاطئة للبحر الأحمر (مثل إثيوبيا في عهد هيلاسيلاسي، أو لاحقًا مع إريتريا)، وذلك لتأمين حضور استخباراتي ومعلوماتي.
ب. المرحلة الثانية: التغلغل الإقليمي وبناء النفوذ:
بعد معاهدة السلام مع مصر، تراجع التهديد المباشر على أمن الملاحة الإسرائيلية، مما أتاح لها الانتقال من الدفاع البحري المباشر إلى سياسة التغلغل الإقليمي.
هذا التغلغل تجلى في:
علاقات مع دول القرن الإفريقي: عبر دعم عسكري أو أمني لبعض الأنظمة (إريتريا، إثيوبيا) مقابل تسهيلات استخباراتية أو لوجستية.
دبلوماسية البحر الأحمر: محاولة الدخول كفاعل “شبه مشاطئ” عبر علاقات مباشرة أو عبر وسطاء إقليميين.
الهدف: خلق بيئة إقليمية تُضعف أي تحالف عربي أو إفريقي يمكن أن يهدد مصالحها البحرية.
ج. المرحلة الثالثة: الاقتصاد كمدخل استراتيجي جديد:
مع تحولات البيئة الإقليمية والدولية في العقدين الأخيرين، بدأت إسرائيل تعتمد المدخل الاقتصادي لتعزيز حضورها في البحر الأحمر، بحيث يصبح أكثر قبولًا وأقل إثارة للرفض الشعبي مقارنة بالتغلغل الأمني المباشر.
الطاقة المتجددة: تعاونت مع بعض الدول في مجالات الطاقة الشمسية والمياه، وبدأت تطرح نفسها كطرف تقني قادر على الإسهام في مشاريع إقليمية على ساحل البحر الأحمر.
التكنولوجيا البحرية: تطوير أنظمة متقدمة للمراقبة، إدارة الموانئ، والأمن السيبراني البحري، مما يجعلها شريكًا اقتصاديًا – أمنيًا في آن واحد.
الاندماج مع المشاريع الكبرى: أبرزها مشروع نيوم السعودي، الذي يُمثل منصة عالمية للتنمية البحرية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا. إسرائيل ترى في نيوم فرصة للاندماج في شبكة اقتصادية – أمنية جديدة، تسمح لها بالوجود في قلب البحر الأحمر عبر البوابة الاقتصادية.
د. دلالات التحول الإسرائيلي:
من الأمن إلى الاقتصاد: إسرائيل لم تتخل عن البعد الأمني، لكنها وجدت أن الاقتصاد والتكنولوجيا يُمثلان أدوات أكثر فاعلية وديمومة للنفوذ البحري.
التغلغل غير المباشر: عبر الشراكات الاقتصادية، تستطيع إسرائيل أن ترسخ حضورها الأمني دون الحاجة إلى قواعد عسكرية مباشرة، وهو ما يقلل الحساسية الإقليمية تجاهها.
إعادة تعريف البحر الأحمر: من مجرد “ممر تهديد أمني” إلى “مجال استثماري وتكنولوجي”، بحيث يصبح ساحة لإسرائيل لتعزيز مكانتها كقوة إقليمية صاعدة.
إستراتيجية إسرائيل في البحر الأحمر انتقلت من هاجس حماية إيلات إلى توظيف الاقتصاد كأداة نفوذ أمني. ومع مشاريع كبرى مثل نيوم، يمكن القول إن إسرائيل تسعى لإعادة هندسة موقعها في البحر الأحمر، بحيث تتحول من “دولة محاصرة بحريًا” إلى “فاعل مؤثر في الاقتصاد والأمن البحري الإقليمي”.
مشروع “نيوم” – نموذج للتداخل الاقتصادي والأمني
يُعَدّ مشروع “نيوم” أحد أبرز المبادرات السعودية التي تجسد التحول من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار. لكن ما يميز المشروع أنه يقوم في قلب البحر الأحمر، ما يجعل له أبعادًا أمنية وجيوسياسية بقدر ما له من أبعاد اقتصادية.
أ. البعد الاقتصادي:
يستهدف نيوم تحويل البحر الأحمر إلى مركز عالمي للنقل البحري واللوجستيات، مستفيدًا من موقعه القريب من قناة السويس وباب المندب.
المشروع يعتمد على دمج الطاقة المتجددة (الهيدروجين الأخضر، الطاقة الشمسية والرياح) مع الصناعات البحرية والسياحة الساحلية، بما يحوله إلى مختبر عالمي للاقتصاد الأزرق.
بفضل موقعه، يُتوقع أن يصبح نقطة جذب للاستثمارات الأجنبية، وشريكًا رئيسيًا في مبادرات مثل الحزام والطريق الصيني أو شبكات الطاقة الإقليمية.
ب. البعد الأمني:
نجاح نيوم مرتبط مباشرة بقدرة السعودية على تأمين الممرات البحرية المحيطة به، وخاصة أن المشروع يطل على خطوط ملاحة تمثل شريانًا لتجارة العالم.
هذا يتطلب:
تعزيز القدرات البحرية السعودية.
ترتيبات أمنية إقليمية بالتعاون مع الدول المشاطئة.
إدماج التكنولوجيا الحديثة في المراقبة البحرية والموانئ الذكية.
من هنا، يتحول البعد الأمني إلى شرط لازدهار المشروع وليس مجرد إجراء مكمّل.
ج. البعد الجيوسياسي:
نيوم ليس مجرد مشروع محلي سعودي، بل مشروع إقليمي – عالمي بطبيعته، نظرًا لحجمه وطموحاته.
وجود استثمارات أجنبية وشركاء دوليين (أوروبيين، آسيويين، وربما إسرائيليين) يجعله منصة لتقاطع مصالح متعددة.
هذا يضع السعودية في موقع “القوة المركزية” في البحر الأحمر، لكنه يفتح الباب أيضًا أمام توازنات وتحالفات جديدة قد تشمل أطرافًا مثل إسرائيل أو الإمارات أو حتى الصين.
نيوم هو أكثر من مشروع تنموي؛ إنه إستراتيجية إقليمية لإعادة تعريف البحر الأحمر: من ممر ملاحي فقط، إلى ساحة تكامل أمني–اقتصادي عالمي.
إسرائيل ونيوم – التقاطعات والتحولات
من زاوية إسرائيل، يُعتبر نيوم أكثر من مجرد مشروع سعودي، بل فرصة إستراتيجية لإعادة صياغة موقعها في البحر الأحمر عبر مدخل اقتصادي–تكنولوجي مقبول إقليميًا.
أ. فرص التعاون:
التكنولوجيا المتقدمة:
إسرائيل تملك خبرات في الذكاء الاصطناعي، الانظمة الرقمية، والأمن السيبراني، و تُعدّ من الدول الرائدة في ذلك. وهو ما يمكن أن يندمج مع الرؤية الرقمية لنيوم كمدينة ذكية.
هذا النوع من التعاون يتيح لإسرائيل الانتقال من مجرد “شريك أمني” إلى “شريك تكنولوجي – تنموي” مقبول إقليميًا.
الطاقة المتجددة:
التعاون في مشاريع الهيدروجين الأخضر وربط الشبكات الإقليمية يمكن أن يحوّل إسرائيل من “دولة محاصرة بحريًا” إلى “شريك طاقة” في قلب البحر الأحمر.
نيوم يطمح أن يكون مركزًا عالميًا للطاقة المتجددة (الشمسية، طاقة الرياح، الهيدروجين الأخضر).
إسرائيل بدورها تطور مشاريع في تحلية المياه، تخزين الطاقة، والربط الكهربائي الإقليمي، ما يجعلها شريكًا محتملاً في ربط هذه المشاريع بشبكات تمتد نحو البحر المتوسط أو الخليج.
التعاون في هذا المجال قد يُعيد رسم خريطة أمن الطاقة الإقليمي، ويجعل البحر الأحمر عقدة وصل بين آسيا وإفريقيا وأوروبا.
تطوير نظم المراقبة البحرية والموانئ الذكية:
إسرائيل قادرة على تقديم حلول متطورة في مجال أنظمة الرادار والأمن البحري، ما يجعلها شريكًا أمنيًا عبر البوابة الاقتصادية في إطار مشروع نيوم، الذي يُطرح كمدينة ذكية متكاملة، قد تجد إسرائيل منفذًا لتصدير خبراتها في إدارة الموانئ الذكية، أنظمة المراقبة البحرية، وربط البنية التحتية بالتقنيات الرقمية الحديثة.
البحر الأحمر يُعد واحدًا من أكثر الممرات البحرية حساسية أمنيًا، وبالتالي فإن أي مشروع اقتصادي ضخم (مثل نيوم) يحتاج إلى مظلة أمنية عالية التقنية.
إسرائيل متقدمة في أنظمة الرادار الساحلي، المراقبة بالأقمار الصناعية، والأنظمة المدمجة بين الأمن السيبراني والميداني.
إدماج هذه القدرات في مشروع نيوم يعزز من قدراتها الدفاعية، لكنه في الوقت نفسه يفتح الباب أمام نفوذ أمني – تكنولوجي إسرائيلي متنامٍ.
ب. المخاطر والتحولات:
اختلال ميزان القوى لصالح إسرائيل:
أي اندماج إسرائيلي في مشاريع البحر الأحمر الكبرى قد يعمّق فجوة القوة مع الدول الإفريقية المشاطئة (السودان، إريتريا، اليمن) التي تفتقر لاستراتيجيات واضحة. فدخول إسرائيل كشريك تكنولوجي – اقتصادي في مشاريع البحر الأحمر الكبرى قد يُكرّس هيمنتها النوعية، في ظل افتقار الدول الإفريقية المشاطئة (مثل السودان وإريتريا) إلى مشاريع مماثلة أو بدائل استراتيجية.
هذا الاختلال يهدد بتحويل البحر الأحمر من فضاء مشترك إلى مجال نفوذ غير متوازن، يتيح لإسرائيل التفوق على حساب جيرانها الأفارقة.
التطبيع الأمني–الاقتصادي:
التعاون الاقتصادي والتكنولوجي في إطار مشاريع مثل نيوم ليس مجرد بعد تنموي، بل هو مدخل لتطبيع أمني مقنّع، حيث يُقبل وجود إسرائيل كجزء من البنية الأمنية للبحر الأحمر بحجة حماية الاستثمارات. وعبر نيوم، يمكن لإسرائيل أن تترسخ كفاعل “شرعي” في البحر الأحمر، بحيث يصبح وجودها أمرًا طبيعيًا مسنوداً بالشراكات الاقتصادية والتكنولوجية.
هذا التطبيع قد يُعيد تشكيل المعادلة الإقليمية، ويحوّل إسرائيل من “فاعل خارجي مشاطئ جزئيًا” إلى شريك إقليمي مشروع، وهو ما يعيد تعريف قواعد اللعبة في المنطقة.
تهميش بعض الدول:
غياب رؤية وطنية لدى السودان أو إريتريا قد يجعلها خارج دائرة المكاسب، لتتحول إلى مجرد ساحات نفوذ للقوى الكبرى بدلًا من أن تكون فاعلة فيها. وفي ظل غياب إستراتيجيات وطنية واضحة لدى هذه الدول، هناك خطر حقيقي من أن تبقى على هامش المشاريع الكبرى مثل نيوم.
هذا التهميش يعني فقدان فرص اقتصادية وتنموية، فضلًا عن تعميق التبعية الأمنية، حيث تصبح هذه الدول مجرد مسرح للنفوذ الإقليمي والدولي بدل أن تكون فاعلة في صياغته.
السودان على سبيل المثال، بامتلاكه ساحل افريقي طويل نسبياً على البحر الأحمر، يمكن أن يكون محورًا رئيسيًا في المعادلة الاقتصادية – الأمنية، لكن الحرب الداخلية وغياب الرؤية الإستراتيجية قد تُفقده هذه الفرصة التاريخية.
ج. المعادلة الجديدة:
نيوم يُشكل “منصة تقاطع” حيث يلتقي الاقتصاد بالأمن، وحيث تُعيد إسرائيل صياغة نفوذها من خلال الاقتصاد بدلًا من الأمن فقط.
هذا التحول لا يعكس قوة إسرائيل وحدها، بل يعكس أيضًا ضعف الدول الإفريقية المشاطئة، التي إن لم تضع إستراتيجيات وطنية واضحة، ستجد نفسها مهمّشة في معادلة البحر الأحمر الجديدة.
ان تداخل مشروع مع اسرائيل و مشاركتها فيه بشكل رئيسي، يؤدي الى خلاصة مفادها :
نيوم: مشروع سعودي يهدف إلى إعادة رسم خريطة الاقتصاد والأمن في البحر الأحمر.
إسرائيل ونيوم: حالة تطبيقية توضح كيف يمكن أن يصبح الاقتصاد مدخلًا للنفوذ الأمني والسياسي.
المحصلة المستقبلية لهذا المشروع هي أن البحر الأحمر سيتحول تدريجيًا إلى مختبر للتكامل الاقتصادي–الأمني، لكن لصالح القوى الأكثر تنظيمًا (السعودية، إسرائيل، الإمارات)، بينما تبقى الدول الأقل استقرارًا (السودان، إريتريا، اليمن) على الهامش.
إن التقاطعات بين إسرائيل ونيوم تفتح الباب أمام فرص تعاون اقتصادية وتكنولوجية هائلة، لكنها في الوقت نفسه تنطوي على مخاطر إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية بما يخدم إسرائيل أكثر من الدول الإفريقية المشاطئة.
وعليه، فإن نجاح هذه الدول في صياغة إستراتيجيات وطنية وإقليمية متماسكة سيكون الفيصل بين أن تتحول إلى شركاء فاعلين في هذه التحولات، أو أن تبقى مجرد متفرجين على إعادة هندسة البحر الأحمر.
انعكاسات على السودان والدول الإفريقية المشاطئة
يُعَدّ السودان نموذجًا حيًّا لفهم ديناميات البحر الأحمر، لأنه يجمع بين إمكانات استراتيجية كبيرة من ناحية، وتحديات أمنية وسياسية عميقة من ناحية أخرى. ومن خلال حالته يمكن استشراف أوضاع بقية الدول الإفريقية المشاطئة (إريتريا، جيبوتي)، التي تواجه أوضاعًا متشابهة بدرجات متفاوتة.
1. الفرص المتاحة والممكنة:
أ. طول الساحل :
يمتلك السودان ساحل طويل نسبياً على الجانب الغربي و الافريقي من البحر الأحمر يبلغ (أكثر من 750 كلم).
هذا الامتداد الساحلي يمنح السودان ميزة جغرافية استثنائية بين الدول الإفريقية المشاطئة.
يتيح له إمكانات كبيرة في بناء موانئ متعددة تخدم التجارة الوطنية والإقليمية (بورتسودان، سواكن، عقيق، أبو عمامة…).
كما يمنحه قدرة على أن يكون جسرًا بحريًا لربط إفريقيا الداخلية (إثيوبيا، تشاد، إفريقيا الوسطى) بالأسواق العالمية عبر البحر الأحمر.
إذا أُحسن استثماره، يمكن أن يتحول الساحل السوداني إلى منطقة لوجستية كبرى شبيهة بدور جيبوتي، لكن على نطاق أوسع وأكثر تنوعًا.
ب. الموقع المحوري بين البحر الأحمر وعمق إفريقيا:
السودان يمثل نقطة تقاطع إستراتيجية بين شمال إفريقيا، القرن الإفريقي، وإفريقيا جنوب الصحراء.
هذا الموقع يجعله قادرًا على لعب دور الممر الاقتصادي – الأمني بين البحر الأحمر والداخل الإفريقي.
من الناحية العملية، يمكن أن يكون السودان بوابة متعددة الأغراض، تشمل:
التجارة العابرة من ميناء بورتسودان إلى إثيوبيا وتشاد.
شبكات الطاقة الإقليمية (نقل الكهرباء أو النفط عبر البحر الأحمر).
مشاريع البنية التحتية العابرة (سكك حديد، طرق، أنابيب نفط وغاز).
ج. إمكانات الاقتصاد الأزرق:
الثروة السمكية: الساحل السوداني يمتلك واحدًا من أغنى المخزونات البحرية في البحر الأحمر، لكنه ما زال غير مستغل سوى بشكل بدائي. تطويره يمكن أن يجعل السودان مصدرًا رئيسيًا للبروتين البحري للأسواق الإقليمية.
النقل البحري: الاستثمار في الأسطول التجاري والنقل النهري–البحري يمكن أن يضاعف من موقع السودان كممر لوجستي.
السياحة الساحلية: سواحل السودان تمتاز بشعاب مرجانية بكر ومواقع غوص غير مستغلة عالميًا، يمكن أن تتحول إلى مورد مهم في ظل السياحة البيئية والبحرية.
الطاقة المتجددة البحرية: الاستفادة من طاقة الرياح والأمواج على السواحل، وربطها بمشاريع البحر الأحمر الكبرى مثل نيوم.
هذه الفرص تجعل السودان، من الناحية النظرية، دولة محورية في معادلة البحر الأحمر، لا مجرد طرف ثانوي.
لكن استثمار هذه الإمكانات يتطلب رؤية وطنية واضحة، واستقرارًا سياسيًا وأمنيًا، إضافة إلى شراكات متوازنة تضمن للسودان دورًا فاعلًا لا تابعًا.
وإذا نجح السودان في ذلك، يمكن أن يتحول إلى فاعل مركزي في معادلة الأمن والاقتصاد البحري، بما يوازن النفوذ الإقليمي لإسرائيل، الإمارات، وحتى السعودية.
2.التحديات و العقبات الماثلة:
رغم الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها السودان على ساحل البحر الأحمر، إلا أن هذه الفرص تواجه تحديات وعقبات جوهرية، تجعل استثمارها أمرًا محفوفًا بالمخاطر:
أ. الحرب الداخلية وانهيار البنية المؤسسية:
الصراع المسلح منذ أبريل 2023 أدى إلى شلل مؤسسات الدولة وانقسام القرار السياسي والعسكري.
البنية المؤسسية المسؤولة عن إدارة الموانئ، النقل البحري، الاقتصاد الأزرق، وحتى القوات البحرية، تعاني من تفكك وتراجع في الفاعلية.
هذه الحالة تجعل السواحل السودانية عرضة:
للاختراق الخارجي عبر قوى إقليمية تسعى لفرض نفوذها.
للفوضى الأمنية (تهريب، هجرة غير شرعية، أو حتى عمليات إرهابية بحرية).
الحرب الداخلية تحرم السودان من التركيز على تطوير سواحله، وتحوّله من فاعل محتمل إلى مسرح صراع بالوكالة.
ب. غياب إستراتيجية وطنية متكاملة للأمن البحري:
السودان يفتقر إلى وثيقة إستراتيجية وطنية شاملة تحدد رؤيته للأمن والاقتصاد البحري في البحر الأحمر.
غياب هذه الإستراتيجية يعني:
قرارات متفرقة مرتبطة بالأزمات بدلاً من التخطيط بعيد المدى.
ضعف التنسيق بين المؤسسات العسكرية والمدنية المسؤولة عن إدارة الساحل.
عدم القدرة على التفاعل مع المبادرات الإقليمية (مثل مجلس البحر الأحمر) بفعالية.
في المقابل، دول مثل السعودية ومصر تملك إستراتيجيات واضحة للبحر الأحمر، ما يمنحها القدرة على قيادة المبادرات الإقليمية، بينما يظل السودان في موقع التابع.
ج. مخاطر الاستبعاد من المشاريع الإقليمية الكبرى مثل نيوم:
مشاريع ضخمة مثل نيوم أو مبادرات الموانئ الإماراتية تُعيد تشكيل الخريطة الاقتصادية للبحر الأحمر.
في ظل الحرب والضعف المؤسسي، هناك خطر حقيقي أن يتم تجاوز السودان كشريك، ليُنظر إليه فقط كساحة عبور أو منطقة نفوذ، بدلًا من أن يكون لاعبًا في صياغة المشاريع.
هذا الاستبعاد يعني خسارة السودان:
فرص اقتصادية مباشرة (استثمارات، وظائف، عوائد تجارية).
مكاسب استراتيجية مثل الاندماج في شبكات الطاقة أو الموانئ الإقليمية.
النتيجة المتوقعة، هي ان يتحول السودان من دولة محورية (بحكم الجغرافيا) إلى دولة مهمّشة (بفعل غياب الإستراتيجية).
إن التحديات التي يواجهها السودان على البحر الأحمر لا تنحصر في الحرب الداخلية فقط، بل تمتد إلى غياب الرؤية الإستراتيجية ومخاطر التهميش الإقليمي.
إذا لم يتدارك السودان هذه الفجوات، فسيفقد فرصة تاريخية ليكون جسرًا اقتصاديًا وأمنيًا بين إفريقيا والبحر الأحمر.
بل قد يتحول إلى فراغ إستراتيجي تُملؤه القوى الإقليمية والدولية، على حساب سيادته ومصالحه الوطنية.
البدائل الإستراتيجية
إن تجاوز التحديات وتحويل البحر الأحمر من عبء إلى فرصة يتطلب تبني بدائل إستراتيجية متكاملة، تجمع بين الرؤية الوطنية، بناء القدرات، والشراكات الإقليمية والدولية. ويمكن تلخيص هذه البدائل في:
1. صياغة رؤية وطنية لاقتصاد المياه الزرقاء:
إن مفهوم الاقتصاد الأزرق لا يقتصر على الصيد أو السياحة البحرية، بل يشمل كل الأنشطة الاقتصادية المستدامة المرتبطة بالبحر (النقل، الموانئ، الطاقة المتجددة البحرية، التعدين البحري).
يجب صياغة وثيقة إستراتيجية تحدد أولويات السودان (أو أي دولة مشاطئة) في استثمار موارده البحرية، مع ربطها بخطط التنمية الوطنية وإعادة الإعمار.
تتمثل العناصر العملية للوصول الى ذلك في، الآتي:
تطوير مصايد الأسماك وفقًا لمعايير الاستدامة.
إطلاق مشاريع سياحية ساحلية منافسة في البحر الأحمر (الغوص، المحميات الطبيعية).
الاستثمار في الطاقات البحرية المتجددة (الرياح، الأمواج، الهيدروجين الأخضر).
إنشاء مناطق صناعية حرة مرتبطة بالموانئ.
النتيجة الحتمية لهذا الإجراء، هو الانتقال من وضع “المستفيد السلبي” من الموقع الجغرافي إلى “الفاعل المبادر” الذي يوظف موارده البحرية لتحقيق تنمية وطنية.
2. بناء قدرات بحرية مدنية وعسكرية متوازنة:
في الشق العسكري :
تطوير أسطول بحري وطني قادر على حماية السواحل والمياه الإقليمية.
تعزيز نظم المراقبة الساحلية و القيادة و السيطرة (رادارات، أقمار صناعية، دوريات بحرية).
تأهيل كوادر بحرية مدربة على إدارة الأزمات البحرية.
الشق المدني:
تحديث أسطول النقل البحري الوطني (سفن بضائع، ناقلات، عبارات).
تطوير مراكز تدريب وبحوث بحرية مدنية (جامعات، معاهد متخصصة).
دعم شركات الخدمات البحرية (إصلاح السفن، الخدمات اللوجستية، الشحن).
يهدف ذلك إلى خلق توازن بين الأمن البحري والدور الاقتصادي، بحيث يكون الأمن مظلة حامية للنشاط التجاري، ويكون الاقتصاد داعمًا لبناء قدرات بحرية وطنية مستدامة.
3. الدخول في شراكات متوازنة تحفظ السيادة وتستفيد من الفرص:
التحدي القائم: كثير من الدول الإفريقية المشاطئة وقعت في فخ الشراكات غير المتكافئة مع قوى إقليمية أو دولية، ما أدى إلى فقدان السيطرة على موانئها أو مواردها البحرية.
لذلك، يجب تبني شراكات قائمة على المصالح المتبادلة وضمانات السيادة الوطنية، مثل:
الدخول في مشاريع إقليمية كبرى (مثل نيوم) بشرط أن تكون الدول الإفريقية شريكًا لا تابعًا.
جذب الاستثمارات في الموانئ والبنية التحتية مع الحفاظ على الملكية الوطنية.
الاستفادة من المبادرات الدولية (الحزام والطريق، مبادرات الطاقة النظيفة) دون الارتهان الكامل لأي محور.
هذا الأمر يؤدي إلى الاستفادة من الفرص الاقتصادية العالمية مع تجنب الوقوع في “فخ التبعية”، وتحويل البحر الأحمر إلى فضاء تعاون متوازن بدلًا من ساحة صراع.
هذه البدائل الإستراتيجية – إذا ما نُفذت بجدية – يمكن أن تُعيد للسودان والدول الإفريقية المشاطئة دورها الطبيعي في البحر الأحمر، بحيث تتحول من هامش يُدار من الخارج إلى فاعل مؤثر يشارك في صياغة معادلة الأمن والاقتصاد البحري.
إن البحر الأحمر يقف اليوم على عتبة مرحلة جديدة من “إعادة الهيكلة الجيوسياسية – الاقتصادية”، حيث تتقاطع مشاريع التنمية الكبرى مع ترتيبات الأمن البحري الدولي.
وتُظهر تجربة إسرائيل مع مشروع نيوم أن الاقتصاد أصبح المدخل الأكثر فاعلية لتحقيق النفوذ الأمني، بينما يشكّل الأمن الضمانة الحاسمة لازدهار أي مشروع اقتصادي. ومن هنا، فإن الدول المشاطئة – وخاصة السودان – أمام خيارين:
إما الاندماج في هذه التحولات عبر إستراتيجيات وطنية وإقليمية متوازنة تحفظ المصالح والسيادة.
أو البقاء على هامش التفاعلات، لتصبح مجرد “مجال نفوذ” تتنازعه القوى الإقليمية والدولية.
وبذلك، فإن استراتيجية العلاقات الاقتصادية – الأمنية البحرية لم تعد خيارًا ترفيًا، بل ضرورة وجودية لتأمين مستقبل الشعوب والدول المطلة على هذا الممر الحيوي.
لم يعد البحر الأحمر مجرد ممر ملاحي عالمي تمر عبره التجارة والطاقة، بل تحول إلى فضاء مركب تتقاطع فيه المصالح الاقتصادية بالضرورات الأمنية، وتتنافس فيه القوى الدولية والإقليمية لإعادة صياغة موازين النفوذ.
وقد أظهر الجزء الأول من هذا المقال أن الدول الإفريقية المشاطئة – رغم امتلاكها أطول السواحل وأكثر الموارد – ما زالت الأقل استفادة بسبب غياب الرؤية الإستراتيجية وضعف القدرات الوطنية. بينما كشف الجزء الثاني، من خلال النماذج التطبيقية لإسرائيل ومشروع “نيوم”، أن الاقتصاد بات المدخل الأكثر فاعلية لترسيخ النفوذ الأمني والسياسي في البحر الأحمر، وأن القوى المنظمة (مثل السعودية وإسرائيل والإمارات) ماضية في تحويل البحر إلى مختبر للتكامل الأمني–الاقتصادي وفق مصالحها.
وعليه، فإن مستقبل السودان وبقية الدول الإفريقية المشاطئة مرهون بقدرتها على:
صياغة إستراتيجيات وطنية شاملة تستثمر الاقتصاد الأزرق وتبني القدرات البحرية.
تعزيز التعاون الإقليمي بعيدًا عن التشرذم والتنافس السلبي.
الدخول في شراكات متوازنة تحفظ السيادة وتجنب التبعية المطلقة للمحاور الكبرى.
إن الخيار الواضح هو، إما أن تكون هذه الدول شريكًا فاعلًا في صياغة معادلة البحر الأحمر الجديدة، أو أن تظل على الهامش مجرد “مجال نفوذ” تُدار قراراته من الخارج و من قبل آخرين.
الاربعاء 3 سبتمبر 2025م