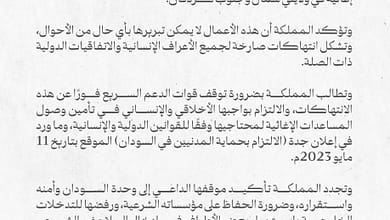توطئة:
احتفلت إثيوبيا يوم 9 سبتمبر 2025 بصورة رسمية بافتتاح سد النهضة كأكبر سد لتوليد الطاقة الكهربائية في أفريقيا، والذي تبلغ سعته التخزينية حوالي 74 مليار متر مكعب ويمتد بطول 1.8 كيلومتر وبارتفاع 145 متراً. ويقع السد في إقليم بني شنقول غربي إثيوبيا ويبعد عن حدود السودان حوالي 10 كيلومترات. وتلاحظ غياب مشاركة السودان ومصر عن الافتتاح بسبب عدم الاتفاق على إجراءات الملء والتشغيل وتبادل المعلومات، وفوق هذا وذاك تملص إثيوبيا من تعهداتها وتوقيعاتها السابقة في المناقشات التي بدأت قبل بداية الشروع في بناء السد في أبريل 2011.
نستعرض في هذا المقال المخاطر والتحديات والتهديدات التي تواجه السودان ومصر، وجولات التفاوض التي تملصت فيها إثيوبيا من تعهداتها السابقة. وباعتبارها مالكة للسد لا ترى أي ضرورة للتوافق والتوقيع على أي اتفاقية ملزمة تقيد إنشاء سدود على النيل الأزرق أو التقيد بقواعد الملء والتشغيل التدريجي، على الرغم من توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لاستخدام المجاري المائية، والميل لتنفيذ خطوات أحادية من جانب إثيوبيا ووضع السودان ومصر أمام الأمر الواقع. الأمر الذي يدفع إلى توترات سياسية تؤثر على القرن الأفريقي والبحر الأحمر والشرق الأوسط، لتشابك وتقاطع العلاقات والمصالح حول المنطقة التي تعاني من الهشاشة الأمنية بسبب النزاعات الداخلية في إثيوبيا ذاتها والسودان، والتوترات الحدودية بين السودان وإثيوبيا، وتباين الرؤى حول المخاطر والمهددات التي تمثلها الإجراءات الأحادية في الملء والتشغيل لسد النهضة، وإمكانية تحول هذه التباينات إلى اختلافات تؤدي إلى اشتعال المنطقة بأكملها. وفي ذات الوقت يبحث المقال في آفاق التعاون وإمكانية التوافق على المصالح المتبادلة، على الرغم من العلاقة الواضحة بين الماء والغذاء والطاقة، وإمكانية تجاوز ذلك إلى استغلال المزايا النسبية للدول الثلاثة: السودان ومصر وإثيوبيا لبناء اقتصاد سياسي تكاملي.
المخاطر والمهددات:
1. موقع سد النهضة يقع على بعد 10 كيلومترات من حدود السودان. تجاوز إنشاء السد توصيات ومقترحات ودراسات لجنة إصلاح الأراضي الأمريكية التي أجرت دراسة جدوى في إثيوبيا في العام 1965. تقول الدراسة بإنشاء سد في الموقع الحالي بسعة تخزينية تبلغ 11 مليار متر مكعب، فتم تجاوز السعة التخزينية لتصل إلى 74 مليار متر مكعب، الأمر الذي يرفع مستوى المخاطر في حالة انهيار السد نتيجة لعوامل طبيعية مثل حدوث الزلازل أو البراكين أو الهزات الأرضية العنيفة.
2. يعتبر السودان ومصر الدول الأكثر تأثراً بسد النهضة فيما يتعلق بسلامة خزان الروصيرص في حالة حدوث انهيار أو حبس المياه أو تدفقها دون تبادل المعلومات. ففي حالة حبس المياه تتدنى نسبة إنتاج الكهرباء ويضعف توليد الكهرباء في الروصيرص ومروي، أما التدفق بدون تنسيق فيسهم في تزايد مخاطر الفيضانات على السكان القاطنين على ضفتي النيل الأزرق.
3. بالنسبة لجمهورية مصر العربية، يتزايد القلق في حالة حدوث جفاف طويل الأمد، الأمر الذي يستدعي إعادة ملء السد العالي، وهو أمر فيه خطورة بالغة على كافة المشاريع الحيوية التي تقوم بها مصر، وهو تهديد بالغ الخطورة على أمنها المائي الذي يُعتبر جزءاً من أمنها القومي.
4. تحولت الفوائد المتوقعة من بناء السد إلى مخاطر ومهددات. ففي يونيو 2020 انقطعت مياه الشرب عن العاصمة الخرطوم نتيجة لانحسار النيل الأزرق لمستوى أدنى من الطلمبات الساحبة المخصصة لسحب مياه الشرب لتنقيتها وضخها كمياه صالحة للشرب، وقد حدث هذا نتيجة لعدم تبادل المعلومات عن بداية الملء.
5. تقول الدراسات بفقدان السودان نحو 50% من الزراعة المطرية الفيضية على ضفتي النيل الأزرق، مضافاً إليها تأثر صناعة طوب البناء نتيجة لانخفاض مستوى الفيضانات.
6. لم تلتزم إثيوبيا في عملية ملء سد النهضة بالنمط المخطط والمتفق عليه وهو من 4 إلى 7 سنوات. جوهر الخطة هو توليد الكهرباء بالتوازي مع أعمال البناء مما يؤدي إلى تقليل فقدان الطاقة الكهرومائية إلى الحد الأدنى وتقليل الآثار على مصر والسودان. عدم الالتزام بالمخطط أدى إلى انخفاض التوليد الكهربائي في خزاني الروصيرص ومروي.
7. تقول الدراسات إن تكلفة بناء سد النهضة وصلت إلى حوالي 4 مليار دولار، ومن المتوقع أن يحقق فوائد تصل إلى مليار دولار سنوياً. هذا الاستثمار الكبير يقع وسط مهددات سياسية وأمنية تحتاج إثيوبيا قبل السودان ومصر أن تحرسه بالتوافق والتعاون بدلاً من فرض الأمر الواقع، والمنطقة بأكملها تعيش حالة هشاشة أمنية وتوترات داخلية وتوترات سياسية بين دول الإقليم ذاتها.
جولات التفاوض والتملص الإثيوبي:
جولات عديدة للتفاوض بين إثيوبيا والسودان ومصر لا يسع المجال لذكرها وتلخيص ما ورد فيها، إلا أن هناك جولات تفاوض بارزة نتوقف عند بعضها لتتضح الصورة للقارئ. أبرز تلك الجولات هي جولة التوقيع على إعلان المبادئ في 2015، ومبادرة الولايات المتحدة الأمريكية والاتفاق الذي صحبها والذي تم التوقيع عليه في 13 فبراير 2020، والذي حدد قواعد الملء والتشغيل أثناء الجفاف والجفاف الممتد والمشاريع المستقبلية وربطها بالاتفاقيات القائمة ووجود آلية لحل النزاعات والطبيعة الملزمة للأداة القانونية والالتزام المعلن باتفاقية الأمم المتحدة لاستخدام المجاري المائية.
إعلان المبادئ في مادته الأولى نص على مبدأ التعاون، والمبادئ الأربعة في القانون الدولي للمياه وهي كالآتي:
(أ) الالتزام بعدم التسبب في ضرر جسيم.
(ب) الحق في الاستخدام المنصف والمعقول.
(ج) تبادل المعلومات والبيانات.
(د) التسوية السلمية للنزاعات.
وتناولت المادة الخامسة التعاون حول الملء والتشغيل، الأمر الذي لم تلتزم به إثيوبيا ورفضت أي أساس ومرجعية. فقد رفضت مقترح السودان الذي ينطلق من اتفاقية 1959، ورفضت مقترح مصر بجعل الوضع القائم أساساً للتفاوض. وبدلاً من الحديث عن الملء والتشغيل، طرحت إثيوبيا قضية تقاسم المياه كشرط مسبق لنقاش ملء السد وتشغيله في محاولات ابتزاز واضحة باعتبارها المالك للسد ودولة منبع تفرض الأمر الواقع، الأمر الذي أوصل المفاوضات العديدة إلى طريق مسدود وتوترات سياسية تتقاطع حول الأزمة السودانية.
هل هناك مخرج وآفاق للتعاون بعد أن أعلنت إثيوبيا رسمياً افتتاح سد النهضة؟
هناك حقائق حول العلاقة بين الدول الثلاثة:
أولاً: بالنسبة للعلاقات السودانية المصرية فهي علاقات راسخة بين شعبي وادي النيل. لذلك تجد مصر عند وقوع الحرب فتحت حدودها واستقبلت ملايين السودانيين، بعكس إثيوبيا التي ظل السودان لأكثر من أربعة عقود يستقبل اللاجئين الإثيوبيين دون كلل أو ملل، فلم ترد الجميل بل أهانت أولئك الذين لجأوا إليها وفرضت عليهم دفع رسوم الإقامة بالدولار. وأحداث منطقة “أولالاء” تكشف بوضوح سياسة إثيوبيا تجاه السودانيين بعكس مصر تماماً، فلا مجال للمقارنة. إثيوبيا أنشأت سد النهضة وعينها على الأراضي السودانية الزراعية الواسعة التي كانت تحتل جزءاً منها عبر مليشيات الشفتة، إلى أن هب الجيش السوداني وحرر هذه الأراضي التي تُقدر مساحتها الكلية بأكثر من 2 مليون فدان. فإقليم قمبيلا وبني شنقول يفوق تعداد سكانهما تعداد سكان السودان نفسه، وهذا الانفجار السكاني لا فرص عمل أو طرق للحصول على الغذاء إلا عبر التعاون مع السودان.
ثانياً: مصر حققت طفرة كبيرة جداً خلال السنوات العشر الأخيرة في مجال البنية التحتية والتقانة الزراعية، وتتبع سياسة الاستثمار في الكادر البشري، فدربت وأهلت مئات الآلاف من العمال والفنيين المهرة ودَفعت بهم إلى سوق العمل في الخليج العربي، فهي مؤهلة لإعادة الإعمار في السودان.
ثالثاً: مشاريع الربط الكهربائي والتبادل التجاري والتكامل الاقتصادي، حيث إن لمصر والسودان تاريخاً مشتركاً في هذا الجانب (التكامل السوداني المصري) أيام حكم جعفر نميري والسادات وحسني مبارك، واتفاق الحريات الأربعة واللجنة الوزارية المشتركة. وعلى الرغم من أن بعض هذه التجارب شاب تطبيقها كثير من الإخفاقات هنا وهناك، إلا أنها تعتبر أساساً يمكن البناء عليه وتطويره.
رابعاً: على السودان ومصر التنسيق وإحكام التنسيق حول ملف سد النهضة كأكبر مهدد في حالة حدوث انهيار نتيجة للكوارث الطبيعية أو نشوء نزاعات مسلحة أو حروب في المنطقة.
إمكانية الحلول وآفاق التعاون:
الحل المستدام يتطلب من الدول الثلاثة: إثيوبيا والسودان ومصر تجاوز قضية الموارد المائية وحدها، والسعي نحو تعاون إقليمي أوسع يشمل المياه والغذاء والطاقة، إلى بناء اقتصاد سياسي تكاملي يعزز الاستثمار حول الغذاء والطاقة باستغلال المزايا النسبية لكل دولة. فالصراع حول سد النهضة ينبع أساساً من توترات جيوسياسية وتاريخية أكثر من كونه مرتبطاً بمسائل فنية أو اقتصادية، فحل الخلافات السياسية يسهم في تحويل السد إلى خانة الفوائد المشتركة بدلاً من تحوله إلى مصدر للتوتر الإقليمي.