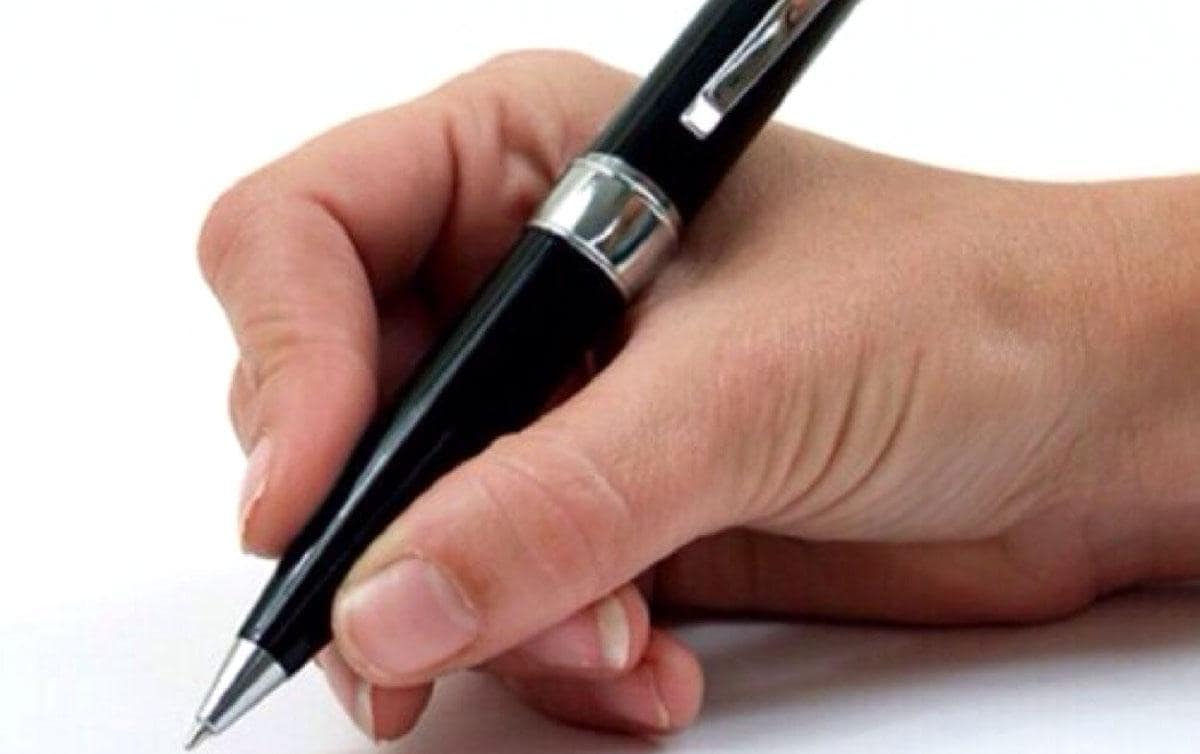في المشهد السوداني المشتعل يسود خطابٌ متكرر يرى أن رفض الحركة الإسلامية لأي هدنة إنسانية هو محاولة لمقايضة الهدنة بمستقبلها السياسي. هذا التفسير الذي أصبح مادة جاهزة في المقالات والبيانات الدولية يبدو للوهلة الأولى منطقياً لكنه عند الفحص الدقيق يحمل خطأً منهجياً جوهرياً، لأنه يبني على فرضية سببية أحادية ويتجاهل طبيعة التعقيد البنيوي في الصراع السوداني.
مبارك أردول الذي يرى أن رفض الهدنة هو تعبير عن خوف من زوال المستقبل السياسي، يختزل الظاهرة في بعدٍ واحد ويهمل منظومة عوامل أخرى. فالمسألة لا تتعلق فقط برغبة الحركة الاسلامية في البقاء، بل بشبكة معقدة من الضغوط والمخاوف والرسائل المتبادلة.
حين تصدر الرباعية الدولية بياناً يعلن صراحة أن لا مستقبل سياسي للجماعات المرتبطة بالحركة الإسلامية، يصبح أي حديث عن هدنة في نظر تلك الجماعات إقراراً مسبقاً بالهزيمة والإقصاء. هنا الرفض لا ينبع بالضرورة من كراهية للسلام بل من فقدان الثقة في العدالة التفاوضية نفسها.
التحليل العلمي لا يقبل تفسيرات أحادية لأن الفعل السياسي ليس نتاجاً لسبب واحد. هناك متغيرات أمنية وقانونية وإقليمية، كلها تتفاعل في لحظة واحدة. تجاهل هذه التفاعلات يقود إلى تشخيص خاطئ، وبالتالي إلى وصفة سياسية فاشلة.
في كل تجارب الانتقال السياسي بالعالم عندما تُعلن القوى الدولية أو الوطنية استبعاد طرف قبل بدء العملية، فإنها عملياً ترفع الغطاء عن أي إمكانية للتهدئة. الفصائل المستبعدة تدخل حينها في وضع الدفاع الوجودي، وتتعامل مع الحرب بوصفها معركة بقاء لا معركة مواقف.
بيان الرباعية الذي أغلق الباب أمام المستقبل السياسي للحركة الإسلامية لم يكن مجرد تصريح دبلوماسي، بل فعل هيكلي خلق بيئة مقاومة. فالحركات التي تشعر أنها ستُحاكم أو تُباد بمجرد قبولها الهدنة لن تجد سبباً منطقياً للتنازل مهما كانت الكلفة الإنسانية. هذا خطأ في تصميم العملية السياسية وليس مجرد خطأ في نيات الفاعلين.
لا يمكن الحديث عن إنصاف أو موضوعية دون الاعتراف بسجل الحركة الإسلامية في السلطة. فقد أفسدت ومارست الاستبداد وأقصت خصومها واستخدمت أجهزة الدولة لإسكات الأصوات المعارضة. هذه وقائع موثقة ولا تحتاج إلى تبرير أو إنكار.
لكن النقد الجاد لا يكتفي بإدانة الماضي بل يسائل ما بعده أيضاً. ما حدث عقب سقوط النظام لم يكن نقيضاً لتلك الممارسات بل إعادة إنتاج لها بأدوات جديدة تمثلت في إجراءات تعسفية وبلاغات كيدية وحرمان سياسي موجه. بهذا المعنى يتحول الإقصاء إلى سلوك متبادل لا إلى قطيعة مع الماضي.
إذن من الخطأ تفسير رفض الهدنة باعتباره عناداً أيديولوجياً، فالمشهد تحكمه دوافع متشابكة من الخوف والانتقام وغياب الضمانات وليس مجرد تمسك بالمواقف.
الفيلسوف جون رولز يرى أن أي نظام سياسي لا يكتسب شرعية ما لم يكن قابلاً للتبرير أمام المواطنين الأحرار جميعاً. ويرى إن الاستبعاد المسبق لجماعة ما من الفعل السياسي يُسقط مبدأ العدالة العامة ويزرع بذور صراع دائم.
وإيريس ماريون يونغ في نقدها للبنى الإقصائية توضح أن طرد فئة كاملة من المجال السياسي لا يحقق استقراراً بل يعيد إنتاج الظلم البنيوي بشكل أعنف.
أما حنّة أرندت فتحذّر من منطق الحركات الشمولية التي تخلق أعداء دائمين لتبرير وجودها. هذه القراءة تصلح تماماً لفهم أزمة الإسلاميين في السودان فهم حين يشعرون أن النظام السياسي الجديد قائم على نفيهم الوجودي يتقوقعون ويعيدون إنتاج ذات سلوك الاستبداد الذي كانوا يمارسونه.
افترض مبارك أردول ان الخوف من الزوال هو السبب الوحيد للرفض دون أن يقدم مقارنة أو معطيات تدعم هذه العلاقة. كما استخدم الحركة الإسلامية ككتلة واحدة رغم تباين مكوناتها الداخلية من شبكات سياسية إلى مجموعات أمنية ومقاتلة.
لم يسأل أردول ما الذي سيكسبه هذا الطرف من قبول الهدنة، أو ما الضمانات التي تحميه إن فعل. بل ظل يكرر الخطاب الدولي نفسه دون مساءلة معقولة لنتائج هذا الخطاب على الأرض.
الاستبعاد لا يصنع سلاماً بل هدنة هشة. والتجارب المقارنة من العراق إلى ليبيا تثبت أن أي عملية سلام تبدأ بإقصاء طرف سرعان ما تنهار أو تنتج سلاماً ناقصاً.
في السودان هذه المقاربة تدفع الإسلاميين إلى الارتماء مجدداً في تحالفات السلاح وتغلق الباب أمام مراجعة داخلية حقيقية. والنتيجة ستكون مزيد من الدم لا مزيد من السلام.
الحل ليس في تبرئة أحد بل في تصحيح طريقة التفكير. الهدنة الإنسانية ليست صفقة سياسية ولا مكافأة لأحد، لكنها أيضاً لا يمكن أن تُفرض ضمن معادلة استئصال.
ينبغي فصل الإنساني عن السياسي فعلاً، عبر خطوات واضحة.
هدنة إنسانية تحت رقابة دولية محايدة لا تتضمن أي التزامات سياسية مسبقة. وآلية مساءلة شفافة تضمن العدالة دون انتقام. وتدرج اندماجي يسمح بإعادة الأطراف إلى الفضاء المدني وفق معايير قانونية وأخلاقية لا أيديولوجية.
أردول الذي صاغ فرضية مقايضة الهدنة بالمستقبل السياسي أخطأ في جوهر التحليل. فرفض الهدنة ليس دوماً رفضاً للسلام بل أحياناً هو نتيجة لانعدام الثقة في العدالة السياسية ولقراءة واقعية لما ينتظر من الإقصاء بعد الهدنة.
النقد الحقيقي للحركة الإسلامية لا يكون بتكرار خطاب استبعادها بل بدفعها نحو مراجعة حقيقية داخل فضاء وطني مفتوح حيث تُحاسب على أفعالها لا على وجودها.
السلام في السودان لن يُبنى على نفي أحد بل على إدراك أن العدالة لا تولد من رحم الإقصاء، وأن الهدنة قبل أن تكون ورقة سياسية هي حق إنساني للناس الذين لا يملكون سوى انتظار توقف الحرب.