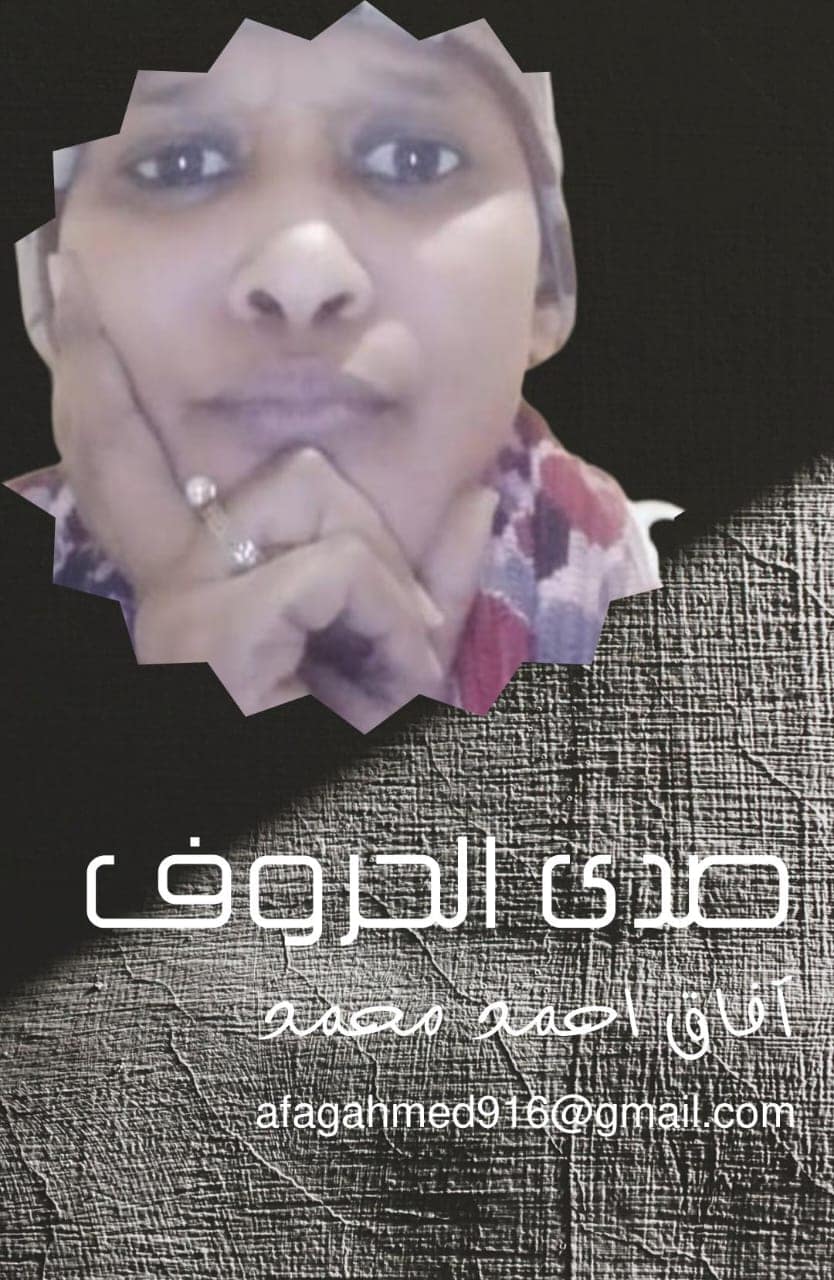في زمنٍ تتبدل فيه الخرائط ببياض الاكفان وتصبح الخريطة الجغرافية مرآةً للدم، يتحوّل السؤال البسيط إلى قاضٍ صارم: من يقود؟ أم أن القيادة أصبحت زينة تُعلق على أعناق الصور والحضور الإعلامي بينما الأرض تحترق تحت الأقدام؟
ذات يومٍ حمل اسم عبد الواحد محمد نور وزناً ومعنى. كان يُنظر إليه كرمزٍ دارفوري، صوت يُطالب بالحماية والكرامة، وصورة تُقاوم فكرة النسيان. اليوم يبدو هذا الوزن مجرد ظل يفقد كثافته. فبدلاً من أن يكون أول من يقف في وجه آلة القمع، صار مشهداً مترادفاً للتردد: بيانات تُصدر، كلمات تُقال، ومشهد إعلامي متقن. وفي الخلفية، بين الصفوف والقرى والطرق الملتوية، ثمن هذا التمثيل يُدفع بالدم.
ليست المشكلة في الكلام وحده؛ بل في الفجوة العميقة بين القول والفعل. الحياد الذي يُقدّم كاستراتيجية في وقت الحرب صار ذريعة لعدم اتخاذ موقف. التحالفات التي تُنسج في الظل تُترجم عملياً إلى تفكيكٍ للثقة، وتفتح المجال أمام الفاعلين الأكثر عنفاً للاستغلال بلا رادع. واللقاءات الرمزية، أو ما يُفهم منها على أنها اقترابات مشبوهة مع مليشيات لها سجلُها الدموي، لا يمكن أن تُقرأ بعفوية بريئة في سياقٍ تحفّه أدوات القتل.
هناك هروبٌ حقيقي وتجارب متكررة للاختفاء. القائد الذي يصدُر اسمه في بياناته لكنه يغيب عن الميدان، أو يدير المشهد من وراء ستائر الفنادق، لا يملك شرعية قيادة في زمنٍ تُقاس فيه القيادة بالحضور بين الناس، عند مداخل القرى، عند سوقٍ جرفته النار. القيادة الحقيقية لا تُقاس ببراعة الصورة الإعلامية، بل بوجود من يضحّي من أجل الآخرين، بقرارٍ يتخذ وسط الرصاص لا في قاعة مكيفة.
التشبّث بمركز القرار واحتكاره دون تفويض ميداني فعال هو جريمة أخرى في سياق هذا الفشل. عندما تتحوّل القيادة إلى امتلاك لوحدة القرار بدلاً من هيكلٍ يوزع المسؤولية، تتحوّل الحركة إلى آلة بيروقراطية عاجزة عن التكيّف، وإلى جسمٍ صلب لا ينبض بمرونةِ مواجهة الحرب الحقيقية على الأرض. الفراغ الذي يصنعه الاحتكار يُملأ سريعاً من قبل قوى لا تُراعي إنسانية، وتُحوّل الخريطة إلى ساحة فوضى وانتهاك.
أما الانشقاقات التي رأيناها بين صفوف البعض، فهي ليست فقط خلافات شخصية أو تحولات تكتيكية؛ إنها انعكاس لثقةٍ منهارة في قيادةٍ تفضّل الواجهة على الحضور. حين يختار القائد أن يحتفظ بكل الصلاحيات ويبتعد عن تفويض من يملك القدرة على التصدي ميدانياً، فإن الساحة تصبح مغناطيساً للانقسام. الانشقاق ليس نتيجة تواطؤٍ فحسب، بل رد فعل طبيعي لمن لا يجد صوتَه ممثلاً في إدارة الحرب أو في صياغة حماية جدية للناس.
وفي وسط هذا المشهد الداكن يبرز صوت مختلف: صوت عملي، لا يلوّح بالخطابات، بل يعمل في الميدان. هنا يظهر اسمٌ مثل مصطفى تمبور، الذي انطلق من نفس البيئة الفكرية وربما نفس الجذور، لكنه اختلف في الممارسة. تمبور لا يصيغ حياداً يُستثمر لتمرير أجندات؛ بل يضع مفاهيم حماية واضحة، يفرّق بين النضال الضيق والنضال الوطني الموسّع، ويعمل على بناء جبهات مدنية وعسكرية قادرة على الصمود. الاختلاف بين من يعلن النوايا وبين من يطبّقها هو الفرق بين صورةٍ تزيينية وبين درعٍ حقيقي يصد الطلقات.
دعونا نكون صافين في التشخيص: اللقاءات أو الاقترابات مع عناصر لها تاريخ من الانتهاكات ليست مقبولاً أن تُركن للرواية. في زمن الحرب، رمزية أي فعل تحمل مدلولاً استراتيجياً. السكوت أو التبرير يتحوّل إلى تحالف ضمني، وتبرير الحضور يصبح بالحقيقة مسوغاً للتمدد والشرعنة العملية. يجب أن يُفهم أن أي صلة كهذه لا تمر من دون ثمن: الخسارة المتواصلة لثقة الناس، وتراكم مناخٍ يسمح بالمزيد من الإفلات من العقاب.
وإذا كانت هناك حاجة إلى قراءة أخلاقية، فالحقائق تُصرخ بصوتٍ واحد: القيادة ليست مُلكاً لأحد، ولا مسرحاً لمظاهر شُعبية مزيفة. القيادة واجبٌ وقرار. وهي اختبار لا يرحم يواجهه القائد في لحظات الخطر عندما يُتطلب منه أن يخاطر، أن يتواجد، أن يشارك الجراح، لا أن يتخذ صورةً مع أم محروقة أو أن يقرأ بيانا صحفيا لصنع وهم الحضور.
الحديث هنا لاينتهي، لكن الواقع أقسى من أي خطاب. لأن الدم لا يعاد، والطفل الذي يموت لا يُسترد، والبيت الذي يحترق لا يعود كما كان. والوقت لا يصنع أعذاراً. من اختار أن يبقى خارج الإجماع، أو أن يتأرجح بين خطاب وموقف دون خطط تنفيذية، لا يمكن أن يطالب بالاحترام؛ ففي التاريخ، لا يُحفظ من تخاذل في ساعة الجد إلا وصمة الفشل.
ما تبقى هو دعوة لا أثر لها في هذا النص، لكنها رأي لا يمكن تجاهله: إن كانوا يريدون أن يُسمع اسمهم في رواية النضال كرموزٍ حقيقية، فليكن الفعل هو معيار القضاة، لا الكلمات. ولمن لا يملك الرغبة في الفعل، فليس للشعب أن يحتفظ به قائداً على رقبته. ولمن يؤدي عملاً واقعياً في خنادق الحماية، فليس للديكور أن ينافسه. إن النضال الذي يبني الدولة لا يولد من الصور، بل من دماءٍ حفظت وعقولٍ وضعت استراتيجياتٍ واضحة، ومن قادةٍ يضحون بسمعتهم الشخصية من أجل بقاء شعبهم.
في النهاية، ليس الحديث عن شخصية أو أخرى فحسب؛ بل هو عن خريطة مسؤولية كاملة أمام التاريخ. أما عن الأصوات التي تعمل وتبني، فستكون حاضرة دوماً، وسينتصر زمن الفعل على زمن الديكور. وأما عن من اختاروا الكراسي المكيفة والتصريحات الفضفاضة، فالتاريخ سيحكم عليهم سريعاً، لأن دارفور لن تنتظر، ولا الدم سيقف عند باب الكلمات