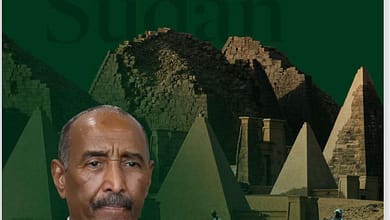أهاج هذه الخطرات حدثان: الأوّل رسالة من صديقِ عُمرٍ عرفته، كما عرفه رفاق دربنا، رجلاً في غاية الحِجى والفضل والرزانة. ومع تواتر تلاقينا عبر الرسائل، أو عند وفوده للسودان أو زياراتي لبريطانيا، لم أقرأ او أسمع من ذلك الصديق كلمة زوراء في حق فرد، أو تأنيباً لأحد، إلا هذه المرة. الحدث الثاني هو ما نقلته لي باحثة مجتهدة من حق أبويها أن يفاخرا بها. ما فتئت تلك الباحثة تطل على الناس عبر الصحف، تكاد تمسك بالجمر وتسير، لا تُبالي، فوق الأشواك.
كتب صديقي الأثير الدكتور فاروق محمد فضل من أكسفورد حيث استقر به المقام وأرفأن العيش – ومن الذي لا يرفئن عيشه في الريف الأوكسوني – يحدِّثني عن أمرين. أمران لا يجمع بينهما إلا رغبة هذا النائي البعيد عن الوطن، القريب منه بالحس والوجدان، في الوفاء بما حسبه ديناً عليه للوطن الذي أنجبه. الأمر الأول هو استنقاذ مؤسسة خيرية بريطانية تعمل في السودان لعون المُستضعفين من أبنائه وبناته. والثاني حول رحيل واحد من عمالقة الطب: الدكتور عبد الحليم محمد. رفأنينة الحياة لم تَحُل بين فاروق وبين الِهمّة بما يدور في بلاده، والعزم على الوفاء بما لوطنه عليه من دينٍ مُستحق.
معاً من أجل السودان
كتب إلىّ فاروق، كما أحسب أنّه كتب لغيري، حول منظّمة “معـاً مـن أجـل السـودان” (Together for Sudan) التي تكاد تنهار. أنشأت هذه المؤسسة الدكتورة ليليان كريق هاريس، زوجة السفير البريطاني الأسبق بالسودان: ألان قولتي. ويضم مجلس إدارتها في بريطانيا نفرٌ من البريطانيين الذين يستهمهم أمـر الســـودان بعيداً عن السياسـة. من هؤلاء، إلى جانب السفير وزوجه، البروفيسور هيرمان بيل الذي عاش زماناً فــي وطـــن النوبـيـيـن بشـمـال السودان. شعــــار المنظّمة هـــو “تمكــــيــن المستضعـفين عـــن طـــريــق التعــــلـــيم” (Power to the Powerless through Education). وتركز المنظمة نشاطها في المناطق الطرفية من الخرطوم، جبال النوبة، مناطق النوبيين في شمال السودان، دارفور. وبتقاعد زوجها السفير ونزوحه إلى أمريكا فقدت ليليان هاريس، كما افتقدت المنظّمة، الدفع الكبير الذي كان يقدمه لها. ميزانية المنظّمة للمشروعات التي نفّذتها لم تتجاوز ربع المليون دولار في العام، إلا أنها حقّقت ما يكشف عن كيف يمكن للمنظمات أن تفعل الكثير بالقليل:
• تدريب مئتين وسبع وأربعين (247) معلماً
• تقديم مئتين وتسع وستين (269) بعثة دراسية جامعية.
• توفير المكافآت المالية لواحد وتسعين (91) معلِّماً.
• تمكين مئة وخمسين (150) طالباً من المصابين بالإيدز من الاستمرار في التعليم والقيام بدورات تدريبية وتنويرية لما يزيد عن الأربعة آلاف شخص من المصابين بذلك الداء الخبيث.
• توفير الإضاءة بالطاقة الشمسية لأربع وعشرين (24) موقعاً.
• تقديم خدمات في طب العيون لقرابة الأربعة عشر ألفاً ممن يحتاجون للعناية شملت قرابة الثلاثمائة جراحة عينية.
استجابة لدعوة صديقي الوطني الغيور الذي اعرف جيداً أنه سخر جزءً من ماله لهذا العمل الخيري وأفلح في حض بعض زملائه من الأطباء على ذلك، أدعو في هذا المقال الخيرين – أفراداً أو مؤسسات – لتمكين هذه المنظمة التي أنشأتها سيدة من غير بني جلدتنا أحبت أهل السودان من أداء مهامها النبيلة. ليس لدي شبهة من شك في حرص هذه الصحيفة على إجلاء الأمر على قرائها، كما لا ينتابني شك في أن في السودان أفراداً ومؤسسات سيقلقهم كثيراً انهيار هذه المؤسسة النافعة.
والنجم إذا هوى
الأمر الثاني الذي أبكى صديقي النائي / القريب هو ما لمسه من إهمال لذكرى واحد من معلميه، بل معلم أجيال من زملائه الأطباء: الدكتور عبد الحليم محمد. يوم أن طرق سمعي نبأ رحيل حليم، وأنا في جوبا، قلت: لم يرحل رجل، وإنما إختَرَم الموتُ نفساً كبيرة، وهوى نجم كان يتلألأ في سماء بلادنا.
في بعض ما كتبت في الماضي أسميت الراحل: “الشيخ الحكيم”. ذلك أسم كان يطلقه الأقدمون على ابن سينا، إذ ما ترك ابن سينا باباً من أبواب المعرفة إلا وطرقه. كتب في الطب – علمه الأساس الذي تمهر فيه – كما كتب في الأخلاق والموسيقى والمنطق والفلك والتوحيد والرياضيات (مُختصر الأرثماطيقا).
أحمد الله على حظوتي بصحبة ذلك النجم الثاقب الذي كان يتلألأ في سماوات بلادنا. لم اعرف حليماً كما عرفه صديقي فاروق معلماً ومدرباً ومنبعاً ثراً لعلوم الطب، بل عرفته كرجل لكل الفصول. وأحمد الله ثانية على حِباء حليم لي بلقائه في كل صقع من أصقاع العالم قادتني إليه ظروف العمل، أو رمتني إليه عوادي البشر والزمان حين ضيَق البعضُ الواسَع في وطننا.
لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها **** ولكن أخلاق الرجال تضيق ومما يضيق به الرجال “احتمال الأذى ورؤية جانيه”. في لندن، باريس، القاهرة، واشنطون، أديس أبابا، كان الملتقى مرات ومرات مع حليم. ولا تسألن حليماً في غدوه ورواحه عن مبتغاه من الترحال. إذا اجترأ سائل على ذلك لقال له:
يقولون لي ما أنت في كل بلدة
وما تبتغي؟ ما ابتغى جَلَ أن يُسمى
يا لها من ملتقيات تلك التي جمعتني مع الشيخ الحكيم. كان الشيخ الحكيم محدثاً ذا أفانين. يحدث عن الأدب شعراً وحكاوي، وعن الغناء شعراء ومؤدين، وعن الرياضة التي هو عليم بأسرارها وخبير بسرائر أهلها، وفي السير، خاصة سير رفاق دربه الذين تنضرت بهم حياته: محمد أحمد محجوب، يوسف مُصطفى التني، خلف الله بابكر، ومحمد عشري الصديق. ما ذكرت اللقيا مع حليم إلا وردت في مخيلتي صورة صديق قديم آخر، صلاح عثمان هاشم. ورغم آصرة القربى بين صلاح وحليم كان الذي جعل تلك الآصرة تتوّشج بينهما ثقافتهما الثرة، وبعدهما عن وساوس الناس وحكاكاتهم. لا أعطش الله قبريهما.
في تلك الملتقيات لم يستنكف الشيخ الحكيم الحديث عن مغامراته فتىً وكهلاً، بل حتّى وهو شيخ يحبو نحو التسعين دون أن يوحي لك ابدأ، أو يجعلك تتظّنى، أنّه كان يتأنق في الشهوات. ما أجمل الصدق مع النفس. لا عجب. أو ليس حليم هو القائل في “موت دنيا” (الكتاب الذي صاغه مع المحجوب) “كانت لنا مغامرات منها البريء ومنها غير البريء”.
آخر لقاء مع الشيخ الحكيم كان في القاهرة عندما هاتفني فتحي محمود ليبلغني – وأنا في حفل عشاء أقامه صديق عزيز: الفريق عمر قناوي – أن حليماً قد وصل لتوه ويوّد لقاءك قبل سفره في الصباح الباكر إلى أوروبا. قلت لفتحي: “سيزدان الحفل بمشاركة حليم، فهيا بكما”. كما قلت لمُضيفي: “هذا سوداني من طينة غير تلك التي عُجِن منها من تعرف من السودانيين: هو سياسي وأديب وطبيب وعالم، وفوق ذلك هو رجل يَتَكثرُ به عارفوه”. ذلك كان هو اللقاء الأخير قبل أن تأخذ بحليم الشيخوخة وتنيخ على منكبيه لتُقعده.
شكـــراً لفــاروق فقــد أوفــــى حليمــاً بعـض حـقـــه: تطـوّع بكتــابة اكثر مـــــن تأبـين لــــه غــــداة وفـــاته: فـــي التايمـز اللندنية، والقـارديان، وحولــية اللــجــــــنة الملكـية للطـب (Journal of the Royal Society of Medicine). ثم ذهب خطوة أخرى بوضع لوحة تحمل أسم الراحل الكريم في مقر الجمعية بشارع ومبول، كلفته مبلغاً ليس بالزهيد لم يستكثره على معلمه، إلى جانب لوحة أخرى باسم زوجة فاروق الطبيبة الراحلة.
رحيل حليم أفجع الكثيرين من أبنائه النبهاء وعَبَر كل واحد منهم عن حزنه بالطريقة التي ارتأى، ولكن تساءلت أين المؤسسات؟ من بين هذه المؤسسات ما بكى وناح بعض القائمين عليها عند وقوع الرزء العظيم. أو هل كان ذلك هو منتهى جهدهم للإبقاء على ذكر الرجل؟
ومن أبى في الرزء غير البُكا
كان بُكاه منتهى جهده
أين جامعة الخرطوم التي ربما لا تستذكر أنّ حليماً كان هو أوّل رئيس لمجلس جامعة الخرطوم غداة استقلال السودان. ذلك منصب كان يحتله قبل الاستقلال الحــاكم العــام وكـــان يطـــلق علــيه اسم الراعي (The Visitor). أو لا يؤهله ذلك المنصب، أن لم يكن قد أهله علمه وعطاؤه، لإنشاء قاعة للمحاضرات باسمه. وأين ولاية الخرطوم ومعتمديتها، أو هل نمى إلى علمها أن حليماً كان هو أول عمدة (Mayor) للمدينة يديرها هو والإداري الحاذق داؤود عبد اللطيف بمفردهما في زمان لم تتوّرم فيه المدينة وتتوّرم إدارتها، وهو ورم خبيث في الحالتين. أو لا يجعل هذا، الشيخ الذي أعطى المدينة وما أبقى شيئاً، حَرياً بأن يُطلق اسمه على جادة أو ميدان عام فيها؟ وأين الصحافة التي تناسل فيها الأبناء والبنات حتى نُباهي بهم الأمم، أو ليس لحليم الذي كان من أوائل مُحرِّري جريدة المؤتمر دين مُستحق؟ ثم أين نقابة الأطباء؟ أتساءل عنها كما تساءل فاروق الوفي في خطابه، ما الذي صنعت لتُبقى على أسم الرجل حتّى ولو كان ذلك بإطلاق اسمه على المُستشفيات التي توّلى إدارتها كأوّل سوداني عند الحكم الذاتي والاستقلال: مُستشفى أمدرمان والمُستشفى الجنوبي في الخرطوم. ثم أين أهل الرياضة الذين كان حليم رسولهم إلى العالمين، فيم وبم تذكروه؟ أو لا يستأهل الراحل الشامخ الذي اضفى باسمه وسمته على الرياضة السودانية زهاءً ومصداقية، أن تنسب إليه واحدة من إستادات الرياضات المتعدِّدة.
ذهب حليم وبقينا نحن خلفاً له، فينا من لا يرحم حياً أو يترّحم على ميّت. تلك حالة تستوجب اللعنة، كحال الإعرابي الذي شهد جماعة تبكي ميّتاً بدمع سخين. قال الإعرابي: “لعنكم الله، تبكون الميت ولا تقضون دَينه”. أسأل الله ألا تصبح بلادنا مثل أورشليم، قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين. (لوقا13: 43، ومتى: 23: 37).
طبيب النفوس ومُلِّقح العقول
الحدث الثاني هو اتصال الطبيبة النفسية ناهد محمد الحسن بي لتنبئني بعمل عظيم ستُقدم عليه مع نفر من عارفي فضل عبقري آخر من عباقرة السودان. مبعث أسى هذه السيدة الميفاءة، هذه المرة، هو استخفاف أهلنا بكبريات الأمور، ومنها إيفاء من قَدّرَوا حق قدرهم. ذِكرُ ذلك العبقري خَفَت في بلد طالما تداول سمع الناس فيه ذكر كثيرين لا غناء عندهم. العبقرية تُنسب لكل من استجاد صنعته وحذق في مهنته وذاع صيته في العالمين، ومن هؤلاء الدكتور الراحل التجاني الماحي الذي نظّمت ناهد للاحتفاء بالذكرى الأربعين لرحيله (9 يناير 1970م) وقد انضم إليها في ذلك الجهد: اتحاد الكتاب السودانيين، مركز قاسم عثمان نور للمعلومات، المؤسسة السودانية للتراث الطبي، ومركز الخاتم عدلان. جميع هؤلاء سيلتقون في رحاب جامعة الأحفاد. لله درّها، تلك المؤسسة التي ظلت تتساعى في هِمّة وسخاء لاحتضان مثل هذه المناسبات.
سألتني، بعد تأسيها على قلة الوفاء، إن كان لدي ما أضيف إلى ما تعرفه ويعرف صحبها عن مناقب الرجل. قلت: أنّ التجاني رجل لا يُوفي حقَّه حديث، ولا يستوعب سيرته مقال، ولا تُجلَي مناقبه العدّة في مطاوي كتاب واحد. فعطاء الرجل للإنسانية كان عطاءً بَتلاً بلا نظير. ثم قلت للباحثة المُلحِفةِ في غير إضجار أو مدعاة للتبرُّم، إن كان لي ما أضيف إلى ما ينبغي أن يكون علم الكافة في سيرة التجاني الحافلة فهو شذرات مما الممت به عن تقدير العالم له في الأروقة الدولية، وعن أثره على العالم المحيط بنا، أو عبر محاياتي له في باريس.
كثيراً ما يرد اسم التجاني، كما يرد اسم حليم، على صفحات الشبكة الدولية للمعلومات مصحوباً بدورهما كأعضاء، أو رؤساء دوريين، لمجلس السيادة، إبان الفترة التي أعقبت انتفاضة أكتوبر 1964م. ذلك المجلس هو أعلى المواقع الدستورية في السودان الذي تتشهاه بعض النفوس. رئاسة التجاني وحليم جاءت إليهما منقادة ولم يسعيا لها، وعلّني أظلم أياً من الرجلين إن قلت عنه: “ولم يكن يصلح إلا لها، ولم تك تصلح إلا له”. يصلح لكليهما كسبهما العلمي الذي تفرّدا فيه، فالعلماء ورثة الأنبياء لا الأمراء. ذلك هو العلم الذي قال عنه أبو حنيفة: “لو علم الأمراء ما نحن عليه من علم لحاربونا عليه بالسيوف”.
عِلمُ التجاني، ونحن في سيرته، طبق الآفاق، فما من موقع ذُكر فيه اسمه إلا وجاء مصحوباً بنعت “أبو الطب النفسي في إفريقيا”. ذلك نعت ينبغي أن يفاخر به السودان، قبل أن يتباهى به المنعوت. وقد أصبح للتجاني في ذلك العلم تلاميذ كثر من السودانيين وغير السودانيين. ومن الأخيرين الدكتور توماس لامبو النيجيري الذي عمل على مدى عشر سنوات نائباً للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية. لم يكتف لامبو باستدراج التجاني ليكون واحداً من كبار مستشاري المنظمة، بل انتهى به الأمر لأن يصبح حوارياً للتجاني. ارتحل لامبو إلى السودان ليقضي ستة أشهر في صحبة التجاني ليتعلم عنه تأصيل الطب النفسي في التربة الأفريقية. قال لامبو لصديق له ولي: الدكتور صلاح منديل الذي كان يعمل تحت إمرته: “لقد تعلّمت من التجاني أكثر بكثير مما تعلّمت من كلية الملك في جامعة لندن ومن جامعة بيرمنجهام”. وأكثر ما تعلّم لامبو عن التجاني، فيما روى، هو أن التجاني لم يكن يعالج المريض الفرد، بل كان يبحث عن علاجه في البيئة المجتمعية التي يعيش فيها، أي أنه كان يعالج أدواء المجتمع. هذا موضوع أقدر مني على الخوض فيه الثلّة من العلماء الأطباء التي ستتلاقى في التاسع من هذا الشهر لاستذكار سيرة التجاني الماحي.
بذلك العلم، رحل لامبو إلى موطنه، نيجيريا ليقوم بثورة في الطب النفسي الذي لم يكن يستهوي أبداً أهل نيجيريا، خاصة فيما كان يعرف عند أهلها وأهلنا بالمصحات العقلية. جاب لامبو كل أنحاء نيجيريا بحثاً على خبراء الطب التقليدي في معالجة المرضى النفسيين، مستهدياً بما تعلمه من التجاني وما خبره من تجاربه في السودان، ليستعين بهم في “تأصيل” المعارف المستحدثة، أو “توطين” الطب النفسي الحديث، كما يُقال برطانة اليوم.
أما محاياتي للعالم الفذ في باريس فقد كشفت لي وجهاً آخر من وجوه ذلك الرجل الموسوعي العظيم. كان التجاني، إبّان عملي بمنظمة اليونسكو، يواظب على زيارة مدينة النور كل صيف؛ لم يغب عنها مرة واحدة طوال فترة إقامتي فيها. وما حط رحاله في تلك المدينة إلا وهاتفني لألحق به في مقهاه المُفضّل، مقهى السلام (كافيه دي لا بيه) في ميدان الأوبرا لتناول قدح من الشاي. وكان الموعد دوماً هو الساعة الخامسة مساءً مما يُنبي عن ترتيب، لا رتابة، في حياة الرجل. فعدم الترتيب في الحياة يعكس دوماً عدم انتظام في التفكير. وما أن تبدأ شمس الصيف الباريسي تتقبض لتدخل في مغربها حتى يقول لي: “هيا بنا إلى الحي اللاتيني”.
كانت الرحلة إلى ذلك الحي “المضمّخ بعطرِ الحضارات” من امتع الرحلات في حياتي: ما مررنا بمعلمٍ تاريخي إلا وأخذ التجاني يروي لي تاريخه وكأنه آثاري. وما أن شهد منظراً تستريح له النفس إلا وأخذ يحدو، بل يترجز في حدائه، لجمال ما رأى. وبين هذا وذاك كان كثير الاستشهاد بالقرآن، وليس ذلك بغريب على حفيد الشيخ حامد أب عصا. وكان في الرجل دوماً تواضع العلماء، ما وجّهت إليه سؤلاً إلا وتَلَدَن في الأمر، أي تمكّث فيه قبل أن يجيب. وما سعيت لمجادلته في شيء إلا وأصغى إليّ في أناة، وفكر فيما أقول في سماحة حتّى وإن كان فيما أقول سخفاً لا يخفى. ذلك رجل فريد، يؤنس به، وتتلّقح العقول بصحبته.
في تلك الرحلة كان السير يحط بنا دوماً عند مكان اختاره هو، ولم أختره أنا ساكن باريس والعليم بدروبها. محّط الرحلة مكتبة صغيرة تقع في شارع مهجور يقع في منطقة سان جيرمان ويُفضي إلى حدائق لوكسمبرج. عَرَّفني الرجل بتلك المكتبة، ولم ابرحها طيلة إقامتي في مدينة النور. في تلك المكتبة كان التجاني يقضي الساعات ينقب عن المخطوطات والخرائط، والرجل النقّاب في اللغة هو الباحث ذو الفطانة. وكلما سألته عن ماذا يبحث؟ كان يقول: “اتبعني يا بني”. كنت أتبعه ليقيني بأنّه أدرى بالشِعاب. لم يكن الرجل، فيما تعلّمت، يبحث عن عيون الكتب الطبية، بل عن كل ما كتبه الرحالة الأجانب عن السودان، وما كُتب عن المصريات، وما كتبه المؤرخون عن حضارات إفريقيا الإسلامية: حضارات كانم ومالي وتكرور. وما أشار إلى الأخيرة إلا وترنم:
أمطري لؤلؤاً جبال سرنديب
وصُبي جبال تكرور تِبراً
سرنديب هو الاسم الذي كان يطلقه البلدانيون العرب على سري لانكا، وتكرور هي موطن التكارير التي كان التجاني يسعى لكي ما يستخرج منها التبر. وما خرج الرجل من ذلك المنجم إلا بالعشرات من الكتب والمخطوطات يحملها وكأنّه يحمل جواهر نفيسة.
التجاني واحد من العارفين، وأحوال الكمال للعارفين، كما يقول مولانا جلال الدين الرومي، “لا يعرفها فج ساذج ومن ثم ينبغي أن نُقصِر الكلام مع هؤلاء ونقول لهم سلاماً” (المثنوي). ذهب العارف ونحمد الله أنا لم نحمل على القول: “ذهب الذين يعاش في أكنافهم”. ذهب العارف بعد أن ترك لنا من ورائه سيرة طبقت الآفاق، وآثار لا يدرك قيمتها الأفجاج، ثُمّ “ثلّةٌ من الأولين وثلّة من الآخرين” تدرك قيمة العلم، وتُبجِّل العلماء، وتحتفي بذكرى العباقرة. تحية لناهد وتحية لجامعة الأحفاد، وتحية عاطرة للمؤسسات التي تستذكر التجاني الماحي في الذكرى الأربعين لرحيله.
بقي لي سؤال ينبغي أن يسأله كل حادب على صيانة ما خلف أمثال التجاني من آثار. ما الذي حاق بمكتبته العامرة التي أهداها لجامعة الخرطوم؟ لا شك لدي أنها لم تنجُ من القوارض الحشرية والحيوانية التي أهلكت الكثير من المكتبات في بلادنا. وكلي يقين أيضاً أنها لم تكن بمنجاة من القوارض البشرية. عَلّ الذين تجمعوا لاستذكار التجاني في أربعين رحيله يصرفون همهم لإنقاذ ما خلف التجاني من ذخائر معرفية في تلك المكتبة.
التجاني فيما أعلم، لم يكن ينظم الشعر إذ انغمس طوال حياته في الكشف عن غوامض النفس البشرية وأسرارها. ولو قُيض له أن يفعل لتقّفي أثر توماس هاردي، القاص والشاعر البريطاني. كان آخر ما سطر هاردي هو قصيدته التي أراد بها رثاء نفسه. قال: تَرى الناسَ إذ يعلمون أنّني أخلدت إلى السكون الأبدي يُطلّون على السماء الحافلة بنجوم الشتاء. يسترقون السمع إلى صوت يناجيهم أن نزل بينهم وبيني ساترٌ يُغيِّب وجهي عنهم، لا يرونه أبداً. ولكن يهامسهم ذلك الصوت بأنّه ولي من كانت عينه لزيمة بكشف الغوامض والأسرار”. وهكذا كانت عين التجاني.