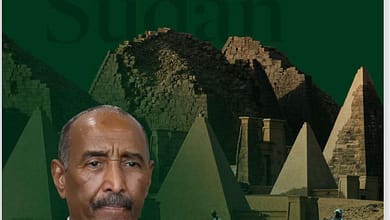“لا يخفي الحاج حمد أن تهوينه من هوية عرب السودان إنما هي سبيل للتفاوض مع الجنوبيين لصيغة جامعة في جدليته للوحدة السودانية”
ملخص
(تبخيس الحداثيين في السودان للهوية العربية وأثرها الثقافي مما سماه الأكاديمي التونسي عبدالحميد هنوم “شناف” (سودانية لـ”الشنف” وهو الاعتراض بترفع) مأثور قومك في كتابه “الحداثة العنيفة: الجزائر وفرنسا” (2010). ففيه نقد دقيق للحداثيين الذين خرجوا من معطف الاستعمار، قال إنه، متى تبنت الصفوة الحداثة كهدية من الغرب لم يعد لتقاليدهم، التي هي عندهم صنو التخلف والجمود، نفع يرتجى. فهي التقاليد نفسها التي عاشها الغرب من قبلهم ورمى طوبتها. فما بقي لهذه الصفوة أن تعمله بها سوى إشانة سمعتها).
تتداول المنابر السودانية منذ وقت طويل مقاطع من فيديو محاضرة للكاتب محمد أبو القاسم حاج حمد عرضت لإشكالية عرب السودان أراد بها هضم عزتهم بخلوص نسبتهم إلى العرب.
فقال إن السودان بلد لم يملك من أمره شيئاً، فحدوده من صنع الخديوية واقتصاده من صنع بريطانيا، وخسرهما معاً لأنه لم تكن للسودانيين يد في كليهما. وقال في معرض الرد على صفوة الهامش ممن يحملون على الشماليين لاستئثارهم بالتنمية دونهم أن التنمية كانت فعلاً إنجليزياً، الشماليون مجرد خدام فيه، فعليه ليس بوسع الشماليين تهميش أحد. ودعا، متى استقام الأمر على ما قال، إلى تفكير استراتيجي لتعزيز جدلية الوحدة مقابل جدلية التجزئة القبلية والطائفية والإقليمية.
ثم التفت في هذا الإطار إلى نقاش هوية الشماليين العربية. فقال إن العروبة في السودان، على علاتها التي سيرد ذكرها عنده، قريبة العهد. فتعود لعام 1505 وهو تاريخ تأسيس مملكة الفونج الإسلامية التي كانت نشأة أفريقية عربية أولى. وخلص من حداثة هذه الهوية وهامشية السودان، قياساً بمراكز الإسلام والعروبة في مثل الأزهر والزيتونة والنجف، إلى هوان شأنها. فقامت فينا بالنتيجة ثقافة شفاهية لا حضارية ليس في جعبتها سوى كتاب يتيم هو “الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء في السودان” وشهرته “طبقات ود ضيف الله” نسبة لمؤلفه محمد نور بن ضيف الله، الحاوي لسير رموز الصوفية السودانية وكراماتهم في القرنين الـ16 والـ18.
وانصرف بعد ذلك إلى تبخسيه كأثر ثقافي في حين يتغنى به كل مثقف سوداني. ومع ضعة شأننا إسلامياً وعربياً، في قوله، تجدنا ندق الصدر نباهي بـ”المشروع الإسلامي العالمي” (وفخم صوته وهو يأتي بهذه العبارة). ووصف هذه العزة بالكتاب “كلام فارغ لم نتعلم به التأدب والتواضع”، وقال لمؤاخذي الشماليين من رموز “الحركة الشعبية لتحرير السودان”، التي قوامها القوميون من جنوب السودان، على عزتهم بعروبتهم إنها “عزة فارغة”. فالشماليون مزيج من العرب وشعب النوبة والبجا الأفريقيين التاريخيين في السودان. ودعوتهم النسبة للعباس عم النبي عليه أفضل والسلام متوهمة. ويفسد زعمهم متى درست التاريخ وعلوم الأنثروبولوجيا. وأنّا لهم النسبة للعباس وأنت ترى أنف الواحد منهم أفطس (وضغط بأصبعين على أنفه لبيان فطسة الأنف)، ومتى قلت للواحد منهم إن العباس براء منكم غضب وتأسف لأنه مدفون في بلد أجنبي ليست عليه قبة تزار.
ولا يخفي الحاج حمد أن تهوينه من هوية عرب السودان إنما هي سبيل للتفاوض مع الجنوبيين لصيغة جامعة في جدليته للوحدة السودانية. فمتى اتفق للصفوة الجنوبية، التي تشكو مر الشكوى من تعالي الشماليين عليهم عزة بعروبيتهم، أن الشماليين أخلاط أفريقية صار بالإمكان مراجعة فكرة الجنوب عن السودان الجديد في وجهة جدلية الوحدة. فليس الشماليون هم مركز للحضارة العربية إلا مكاء وتصدية ما دام أن كل حيلتهم كتاب “طبقات ود ضيف الله”، فهم أفارقة منكرون.
وقال إن أقواله تلك عن بطلان هوية الشماليين العربية الخالصة أغضبت أحدهم، فحكى له عن طائر أم قيردون ليقول له أنتم مثله في غلو المزاعم. فمن عادة هذا الطائر أن ينام وأرجله مرفوعة إلى أعلى، فسئل عما وراء ذلك، فقال أخشى أن تسقط السماء ليلاً والناس نيام فأتلقاها بأرجلي وأنقذ العالمين. وهذه المساومة لتعزيز وحدة السودان بتقليل دسم العروبة في هوية عربه بالكشف عن خلطتهم الأفريقية قديمة، بل هي مما قامت على معمارها أشف الحركات الأدبية وأنبغها مثل مدرسة “الغابة والصحراء” في الستينيات.
عوار نهج الحاج حمد في هضم عزة عرب السودان بهويتهم كثير. سنتجاوز ما سبقت الإشارة إليه من أن التهوين بها مما أراد منه استرضاء أهل هويات آخرين ليعقد بينهما في الحلال، أي الوطن. وسنكتفي هنا بعرض المآخذ المنهجية على عبارة الحاج حمد.
فعلوم الإثنوغرافيا ليست من رأي حاج حمد في تكذيب الناس في دعواهم بهوية، فلا يسعى عالم الإثنوغرافيا إلى تجهيل رواته والازدراء بهم لجهلهم بعوالمهم الثقافية. فكل ما بوسعه عمله هو جلاء كيف أدرك هؤلاء الرواة هذه العوالم وكيف استنطقوها ما شاؤوا. فغرض هذا العالم ليس مساءلة ومغالطة الحقائق التي قامت عليها هوية الجماعة موضوع درسه، أو صرف المبادئ التي اهتدوا بها كضلالات. ولن تخلو هوية ما بالطبع من أخطاء أو أهواء إلا أن رمي أهلها بسوء النية أو العزة الجوفاء، كما فعل حاج حمد بعرب السودان، فخطة عقيمة، بخاصة حين يكون التحدي هو الكشف عن لماذا فكروا في المسألة على نحو ما نرى، وليس ابتداء البحث بافتراض توافر الإجابة قبلاً.
وليست التراتبية بين الكتابة والشفاهية التي قال بها الحاج حمد، من الجانب الآخر، مما يتفق فيه معها الاختصاصيون في المجال، فعندهم أنهما متعادلان. وبعد هذا التقرير لم تعُد مهمتهم المفاضلة بينهما، بل دراستهما كعالمين معقدين. وأفضل من عرض لاستحقاق الثقافة الشفاهية واستقلالها بكينونة هو روبرت أونق في كتاب عمدة هو “الشفاهية والكتابية” (1982). فنظريته المركزية أن الشفاهية والكتابة كونان ثقافيان يفترض كل منهما إطاراً من الفكر شديد الاختلاف عن الكون الآخر. وقعّد أونق خصائص الثقافة الشفاهية ومن ذلك قوله إنها تمجد الذاكرة، ولذا تكتسب فنيات الذاكرة ضمنها أهمية عظمى في تشكيل هوية أهلها وحكيهم، وتؤثر هذه الأشياء بدورها في التفكير وبالنتيجة في الوعي.
ونأتي بعد هذا إلى بيت القصيد في العوار وهو تهوينه كتاب “طبقات ضيف الله” لغلبة كرامات الأولياء غلباً عده به كثير من أهل الحداثة أضغاثاً وخرافات. وكان طلاب لمدرسة الأحفاد بأم درمان خلال الخمسينيات اشتكوا لصحيفة سودانية عن دروس في الكتاب كان يلقيها عليهم عميد المدرسة بابكر بدري، المحارب القديم في الثورة المهدية.
تبخيس الحداثيين في السودان للهوية العربية وأثرها الثقافي مما سماه الأكاديمي التونسي عبدالحميد هنوم “شناف” (سودانية لـ”الشنف” وهو الاعتراض بترفع) مأثور قومك في كتابه “الحداثة العنيفة: الجزائر وفرنسا” (2010). ففيه نقد دقيق للحداثيين الذين خرجوا من معطف الاستعمار. فقال إنه، متى تبنت الصفوة الحداثة كهدية من الغرب، لم يعُد لتقاليدهم، التي هي عندهم صنو التخلف والجمود، نفع يرتجى. فهي التقاليد نفسها التي عاشها الغرب من قبلهم ورمى طوبتها. فما بقي لهذه الصفوة أن تعمله بها سوى إشانة سمعتها. وربما فسرت استراتيجيتهم هذه في شنف مأثور قومهم عقم خطتهم المشاهد في تغيير ما بأهلهم بالحداثة. فكيف يغير مثلهم ما بقوم هم من سوء الظن به بمكان؟
ولم تمنع الحداثة في حواضنها الأصل في يومنا عالم الماورائيات والكرامات، في حين اعتزلها حداثيون في بلد كالسودان وخرفوها، أي صرفوها كخرافات.
فنقلت الأخبار منذ أسبوعين عن تقاطر مئات العباد الكاثوليك لشهود قداس استثنائي الكرامات لحمته وسداه. فتقاطروا إلى ساحة الفاتيكان لشهود ترسيم كارلو أكوتيس (1991-2006) قديساً. وكان صباه التقي نفسه عنوان قداسته. فتقول أسرته إنه كان صبياً كسائر الصبية إلا أنه كان بخلافهم دائماً، فنطق كلمته الأولى وهو وليد ستة أشهر واستوت عبارته وهو ابن نصف سنة. وافتتن بالعشاء الأخير للمسيح في حين انشغل ربعه بما انشغلوا به، فسهر الليالي يبحث عن معجزات ذلك “الطريق إلى السماء” في قوله.
وبدا أن الكنيسة الكاثوليكية وجدت في ترسيم أكوتيس، البارع في التقنية الحديثة والمحب للعب الفيديو، معبراً إلى جيل حدث تعثرت دونه. وكانت إجراءات ترسيمه الأسرع طراً وبلغت جماهيريته الذرى. ونوه البابا بأن أكوتيس عرف أن وسائط الاتصال الحديثة هي لإذاعة الإنجيل في البر والبحر وبث القيم والجمال بين الناس. وقال في كلمته في الترسيم “هذا يوم عجيب لإيطاليا، للكنيسة جمعاء، ولسائر العالم”.
وسنتجاوز هنا من رأوا في ترسيمه على وجه العجلة ذلك أنه راجع إلى انتمائه لأسرة لها تأثير في دوائر الفاتيكان وخيرها سابق للكنيسة. فقالت أمه إنه كان يوزع مصروفه على فقراء مدينة ميلان، وقال مدرّس له إنه كان رؤوفاً بزملائه فمن وجده معتزلاً سرى عنه، ومن رأى منه عثرة في الدرس أخذه إلى دارهم وأعانه على نائبته. ومات بسرطان الدم واحتشد في جنازته خلق لبدا من كل ألوان الطيف السياسي والديني والاجتماعي.
ولا يُرسّم أحد قديساً إلا بعد مرور خمسة أعوام على وفاته، ويزكيه للرتبة قسيس في ناحيته بعرض الفضائل الاستثنائية التي تمتع بها، ويستدعى الشهود ممن وقفوا على نبالة المرشح للقدسية، وتقدم الدلائل عليها وتفحص قبل أن يبعث الملف إلى الفاتيكان. ويتصل التحري لا يزال بما في ذلك اضطلاع قائم بالأمر في طاقم الفاتيكان بالبحث في الأمر، علاوة على إثبات وقوع كرامتين من هذا المرشح لرتبة القديس. وترسيم المرشح قديساً في طور باكر يأتي بعد ثبوت الكرامة الأولى. وحدثت هذه الكرامة لأكوتيس عام 2020 لصبي من البرازيل شفي من داء البنكرياس بعدما دعت أمه باسمه. وجاءت الكرامة الثانية من بورتو ريكو عام 2022، فشفيت فتاة دعت لها أمها باسم أكوتيس من رضوض نفسية في أعقاب إصابة بدماغها.
وهذه كرامات مما استنكره حاج حمد في “الطبقات” وأخرج عرب السودان إلى عروبة بلا دسمها.
يقول السودانيون في مثل هذه المفارقة عن سماحة الجهة في أصل الأمر وتشدد الجهة الفرع، أهل البكاء غفروا والجيران كفروا. ويبدو أنه ربما في هذا “الكفر” ما يفسر تضاؤل نفوذ القوى الحداثية حتى سخر منها الساخرون بقولهم إنها صارت من الانكماش عدداً لا تملأ به حافلة ركاب.
*محمد ابو القاسم حاج حمد: عرب السودان خالي دسم عربي عبد الله علي إبراهيم*