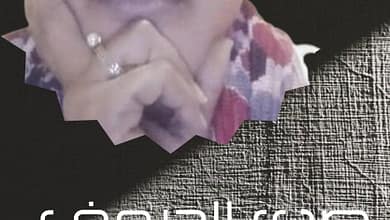انعقد في 16 مارس 1965 مؤتمر المائدة المستديرة للتداول في مسألة الجنوب بعد ثورة أكتوبر 1964 تداولاً التزمت به الثورة لأنها هي نفسها مما خرج من صميم مواجهة بين نظام الفريق عبود (1958-1964) والقوى المعارضة له حول نهج النظام في إخراس “التمرد” الجنوبي بالعنف المفرط. وامتنع عن المشاركة في المؤتمر جناح من الاتحاد الوطني الأفريقي السوداني (سانو) بقيادة أقري جادين لموقفه بوجوب انفصال الجنوب عن الشمال. وحاصر المؤتمر من جهتين: فمن الجهة الأولى لم يستجب الجناح العسكري للحركة لدعوة الحكومة الجديدة له لوقف إطلاق النار من الجانبين وواصل نشاطه المسلح في الجنوب حتى عادت الحرب الأهلية في 1966 كأن شيئاً لم يكن. ومن جانب آخر كانت حجة أقري جادين على مطلب الانفصال هو عاذرة تاريخ للرق انعقد بين شقي السودان مما كان أيضاً حجة الجنوبيين المقدمة في مؤتمر جوبا في 1947 لاعتزال ترتيبات الحكم الذاتي للسودان التي كانت تحت النظر. وكانت تلك ملابسات ميلاد مصطلح “أحفاد الزبير باشا” نسبت به جماعة أقري جادين الشماليين إلى “جد” لهم هو الزبير باشا تاجر الرقيق في نواحي بحر الغزال في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.
ألقى عبد الخالق محجوب كلمة عن الحزب الشيوعي في المؤتمر المائدة المستديرة عما رآه حزبه عن مسألة الجنوب. ولكن ما احتفظت به الذاكرة السودانية على علاتها ما تزال هي عبارته في الرد على نسبتهم للزبير باشا:
“كم تمنينا لو شملت رياح التغيير (التي تناولها) بعض إخوتنا ممن يحبذون نعتنا “أحفاد الزبير باشا”. حسناً نحن احفاد الزبير باشا (ضحك) فإننا لا نتوارى من تاريخنا. ولكننا ننتقده بموضوعية وبدون مرارات. نحن نتعلم درساً من كل ذلك بيننا . . … فأحفاد الزبير تقدموا مع خطى الزمن لبناء السودان الجديد، ومؤسساته التقدمية ومن بينها الحزب الشيوعي السودان (ضحك)”.
نبدأ بتصحيح نص عبد الخالق الذي ورد على قلم منصور خالد الذائع. فجاء ذكره عنده على النحو التالي:
“نحن فخورون بأن نكون أحفاد الزبير”. وعلق منصور: ويا لذلك من فخر . . . فأي تفاخر بالرق يدخل في باب المعايب والمثالب”.
وقد نحدس أن من وراء بقاء عبارة عبد الخالق في الذاكرة هو أنها خاطبت ما يعرف ب”خطايا السلف” بحق الجنوبيين وغير الجنوبيين بعزائم اهترت بالزمن حتى وقعت طائفة من الشماليين ومن حزبه هو نفسه، في حبائل ما عرف ب”عقدة الذنب الليبرالية” حيال ما أرتكبه سلفهم من جرائر بقوم جار جنب.
فانتابت هذه العقدة اليسار وطوائف كثيرة تجاه جماعات الأقلية السودانية التي ذاقت الأمرين من الرق، والقسمة الضيزى في السلطان والثروة من السلف الشمالي العربي المسلم. ومن المعروف أن هذه العقدة تصيب الجماعة التي بلغت من الوهن عتياً من جهة مطلبها الاستراتيجي وهو الزمالة في الأمة. فجاء اليسار وغيره إلى الساحة السياسية ببرنامج لبناء المجتمع المتآخي. ثم رأى بالزمن أن البرنامج وفنطازيته تتبخر أمام عينيه من جراء تلك الهزائم التي مني بها فانتهت به إلى قلة الجرم والحيلة. فحين لا يعود بوسع جماعة سياسية ما أن تبشّر بصدق واستقامة بالألفة القومية تنتهي إلى وخز الضمير، وندب عار أهلها وقبيلها حيال الجماعات المُضَطَهدة. وهذه خطة بائسة تلتحف التشكي والفضح والابتزاز بدلاً عن الفعل والتغيير والإنجاز. ومعروف أن هذه العقدة أوسع الأبواب لعقم السياسة لأن المصاب بها يتعاطى الآخر، الجنوبي في حالنا، بوصاية وشفقة خلوا من الفعل والبركة.
خاض الشيوعيون في الرق بغير شيخ
لقي الشيوعيون من حزب عبد الخالق بشعور بالخطيئة من أثم الأجداد إثارات الرق في الثمانيات الثانية من القرن الماضي التي عززت مظلومية الجنوب الذي خرجت الحركة الشعبية لتحرير السودان لرفعها بالسودان الجديد. ولم تحل دونهم وعقدة الذنب أن الرق عندهم، مادياً تاريخياً، ليس من حقائق التاريخ فحسب، بل هو أيضاً مرحلة بحالها في تاريخ العمل واستغلاله لم يسلم منها حتى من رحم. ناهيك من أن يلقوها بعزائم عبد الخالق الذي كأنه قال للائميه بوزر الأجداد النخاسة “كان ومضى وأصبحنا للمقبل” المروية عن عثمان دقنة. فقيل إن دقنة لما ألقى الإنجليز القبض عليه وجد من يعيد عليه مستنكراً وقائع منه خلال أمارته على شرق السودان. فقال له العبارة.
وكان مأمولاً في كتاب زعيم الشيوعيين محمد إبراهيم نقد “علاقات الرق في المجتمع السوداني” (1995) أن يكون الكتاب الهادي إلى سواء سبيل الشيوعيين بشأن مسالة الرق التي هجمت عليهم ولم يستعدوا لها يومها في انشغالهم بالطبقة والنوع في التحليل السياسي دون العرق.. وقد أثنى الكل على صبر نقد على وكد الدرس. بل لام منصور خالد أهل الاختصاص لاضطرارهم رجل في مشاغل نقد أن يتفرغ لبعض تبعتهم. وقد توافرت بفضل الكتاب للباحثين وثائق جمة عن الرق كان طلبها عزيزاً مكلفاً.
ولكن نقد لم يتورع من محاكمة الوثائق بحكم قيمة وقته مما عرضه لعقدة الذنب الليبرالي. وقد فشا هذا الذنب بين من استفاد من كتابه من اليساريين الشماليين المُحرَجين من سوءات سلفهم باسترقاقهم أقوام سودانيين آخرين. وقد اتخذ ترخيص نقد لقارئه بخلط أوراق الماضي بالحاضر عدة صور. فنقد يجرؤ أحياناً باقتراح صياغة بديلة لما لا يرضاه من مادة الوثيقة. وله أيضاً تعليقات أطلق العنان فيها لسجيته المعاصرة ليحاكم عصراً ساد ثم باد. فقد جاءت عند نقد “بعد أيه؟” في تعليق على وثيقة جاءت بآخره بما توقعه نقد منها بأوله.
ومن أعنف أبواب رخصة نقد للإزراء بالماضي حكماً بالحاضر ضجره الخاص من شكنده، ملك النوبة المسيحي على عهد المماليك في مصر (1382-1399)، الذي تهافت، في قول نقد، في قسم تتويجه بمصر والتزم لزوم ما لا يلزم حيال ولي نعمته الملك الظاهر بها. فقد وصفه نقد ب”سقط المتاع” “أخونا في التاريخ والوطن . . . لا شمله الله بمغفرة فقد “كسر ضهرنا” . . . تهافت هذا “الإضينة” (الأذينة)، وهو الحر سليل بعانخي وتهراقا، وحفيد رماة الحق”. ثم لقي منه أعيان السودان، الذين كتبوا للإنجليز في 1927 يستبطئونهم إجراءات تحرير الرقيق، نفس التهزئة. فقال إنها مذكرة متهافتة تفوح منها “نكهة سودانية” جُبلت على جعل كل ما يقع في السودان لا يماثل نظيره في كل مكان آخر. وقال إن هذه عنجهية “توهم أهل السلالات العربية الإسلامية، وكأنهم الشعب المختار حتى بين خير أمة أخرجت للناس”.
وأعفى الكتاب بمنهجه في الحكمة العاقبة للفعل التاريخي الشيوعيين من الشغل الماركسي المر وهو رد ظاهرة الرق إلى نمط الإنتاج وعلاقاته في اقتصاد موصوم عندهم ب “التقليدية” رغم جرثومة الحداثة التي ظلت تنخر فيه. ولما تجافى اليساريون الشماليون هذا الكدح لم يبق لهم من الأريحية غير تفريج عقدة ذنبهم الليبرالية تجاه من كانوا هدفاً تاريخياً، أو آنياً، لنخاسة أهلهم. وككل مصاب بالوزر الليبرالي لم يسفر الشيوعيون من الشماليين عن غير الكشف بعد الكشف بعد الكشف عن أرشيف سخطهم على السلف الطالح.
ولو تأهل اليسار بعلم اجتماع العبودية لوجد أن ملابسات الحرب الأهلية وتهافت نسيج الريف الاجتماعي بالجفاف والنزوح والغلاء مما يؤدي إلى الرق بغير حاجة إلى إضفاء مسحة عرقية عليه. ومن المؤكد أن هذا العلم كان سيمد لهم قنطرة إلى الريف الذي تجافوه بعد همتهم فيه في الخمسينات واعتصامهم بالمدن. ومن شأن هذا الحضور في وقائع الريف أن يجعل الرق يتنزل عندهم في سياق زلزلة بيئية وإقليمية ووطنية وعالمية أخذت بخناق الريف منذ حين. وسماها الدكتور أليكس دي وال “صدأ الريف” من فرط بأسائها.
فوقع الرق موضوع نظرنا في مناطق تبخرت منها الدولة، أو تواطأت فيها بالفتنة الرعناء تنصر جماعة على أخرى لتمدد من عمرها السياسي بفرق تسد. وبالنظر إلى هذا الخراب أصبح استرقاق الناس حيلة بغيضة للحصول على أيد عاملة، أو أفخاذ منتجة جنسيًا برخص التراب. فقد صدئ الريف من طول الإهمال وصار البقاء فيه للأقوى. فلم يقع الرق في مناطق التماس بين عرب السودان وأفارقته لأن العرب من رزيقات وغيرهم نخاسون بالسليقة العربية. فقد مارسه جنوبيون على جنوبيين حتى في الثمانينات كما جاء في كتابي “أنثروبولوجيا الخبر: الرق في السودان” مما يطعن في صدق من رده إلى عاهة في ثقافة أرومة عربية كانت أو أفريقية.
*عبد الخالق محجوب في عيد ميلاده الثامن والتسعين (23 سبتمبر 1927): أحفاد الزبير باشا وعقدة الذنب الليبرالية (1-4) عبد الله علي إبراهيم*