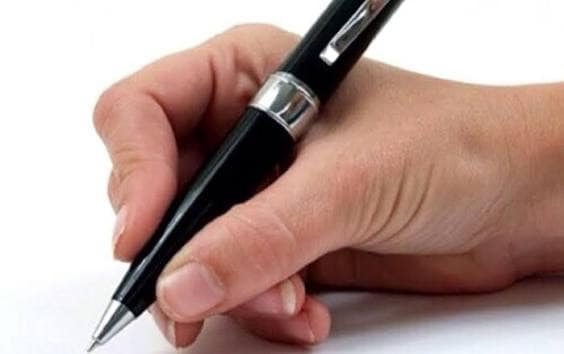ثار بركان “هايلي غوبي” Hayli Gubbi في سلسلة إرتا آلي Erta Ale بإقليم عفر الإثيوبي بعد سباتٍ امتد لعشرة ألاف سنة، واندفع رماده ليعانق ارتفاعات شاهقة تجاوزت 42 ألف قدم، عابراً البحر الأحمر ليظلل أجزاءً من اليمن، ثم واصل مسيره محمولاً برياحٍ عليا حتى بلغ تخوم الهند وباكستان؛ بدا الحدث صاعقاً للخيال العام. إنه في منطق الطبيعة تذكيرٌ صارم بأن الزمن الجيولوجي يتحرر من “توقعاتنا” البشرية القصيرة، ليخضع لإيقاعه الذاتي المفطور عليه. إنها لحظة اليقظة والاندفاع التي تتضاءل أمامها إرادة الإنسان، وتسود فيها زمجرات الطبيعة.
ورغم أن البركان قد يفتقر لصلة هندسية مباشرة بسد النهضة الإثيوبي، إلا أن لحظة ثورانه تشرع الباب أمام سؤال بالغ الخطورة: هل نمتلك — كدولة ومجتمع — مخيالاً علمياً قادراً على استشراف المستقبل بمنطق الاحتمالات بعيداً عن الركون للقدر؟
الظواهر الطبيعية لا تموت، لكنها تدخل في سبات. فالسكون الذي نتوهمه استقراراً هو — في لغة الجيولوجيا — مجرد “هدنة طويلة”. البركان الذي نام قروناً استيقظ فجأة لأنه “اختار اللحظة”، ولأن العوامل التحتية تراكمت حتى بلغت نقطة الانفجار. وهذه الفكرة هي جوهر إدارة مخاطر الكوارث: إن ما يبدو مستحيلاً اليوم قد يغدو واقعاً غداً. والواقع أن الطبيعة نادراً ما تفاجئنا، بقدر ما تكشف عن غفلتنا؛ فنحن لم ندرّب خيالنا على استقبال الاحتمال. والاحتمالات — في عرف إدارة المخاطر — تتجاوز كونها هوامش في التقارير، لتصبح قلب الفعل نفسه.
إن علم إدارة الكوارث يقوم على مبدأ بسيط وثوري: “كل ما يمكن أن يحدث — ولو بنسبة ضئيلة — يجب أن يوضع له سيناريو”. الأمر هنا يتخطى نظرة التشاؤم ليؤسس لصلابة الواقعية. فمنهج هذا العلم يرتكز على قاعدة: “الحدث منخفض الاحتمال، عالي الأثر”، والتعامل معه يقتضي اليقظة والتحوط بدلاً من التضخيم. لذلك، تنأى إدارة الكوارث بنفسها عن التنجيم والضرب بالغيب، لتكون علماً يحتفي باليقظة: يقظة تجاه المتغيرات، وتجاه الزمن الطويل، وتجاه الاحتمالات التي نمحوها من عقولنا حفاظاً على أمننا الإنساني.
وما يثير الأسى، وجود نمط تفكير يقف في الضفة المقابلة للعلم؛ منهجٌ ثقافيٌّ مترسّخ يمكن وصفه بـ “التواكل القدري”. هذا المنهج يعطّل العقل والعلم حين يحيل المستقبل إلى “أمر غيبي محض” مُقصياً أي مجال لتدبير الإنسان. وحين تقع الواقعة، يتكرر المشهد المعتاد: يختبئ الإهمال الإداري خلف جدار القدر، ويجد سوء التخطيط لنفسه غطاءً في شعارات دينية مفرغة من مضمونها، ويُطالب الضحايا بالصبر، بينما يُعفى المسؤول عن المساءلة. وهكذا تتشكّل “الكارثة المركّبة”: كارثة من الطبيعة، تعلوها كارثة من الثقافة. فالقدر بريء من هذا التوظيف، والتوكل الحقيقي يرتكز أساساً على الأخذ بالأسباب ويبدأ منها (أعقلها وتوكل).
بالعودة إلى السد الإثيوبي، فهو لم يُشيّد ليرحل بعد سنة أو سنتين؛ إنه منشأة معمرة قد تمتد لقرنٍ أو أكثر. وهذا المدى الزمني وحده كافٍ لوضعه في خانة “المشاريع الحساسة جيولوجياً”، حيث الزمن الطويل لا يتسم بالحياد، وقد يحفل بالمفاجآت. السؤال العلمي — المجرد من السياسة — والذي يتأسس عليه علم إدارة مخاطر الكوارث What if هو: ماذا لو مرَّ بالمنطقة طائفٌ من زلزال بعد مئة عام أو في غضونها؟ أو ماذا لو تكرّرت أنماط النشاط الجيولوجي التي أيقظت بركان “هايلي غوبي”؟
السد يحجز خلفه 74 مليار متر مكعب من المياه. هذه الكتلة الهائلة تتجاوز كونها مجرد مياه؛ إنها “طاقة كامنة” يستحيل تجاهلها في أي سيناريو. فإذا كان الرماد البركاني الخفيف قد عبر البحر ووصل أثره إلى جنوب آسيا، فكيف يمكن أن يكون اندفاع المياه الثقيلة إذا انهار السد؟ الحديث هنا يتخطى الخيال السينمائي ليلامس نماذج علمية تُدرّس في إدارة مخاطر البنى التحتية الكبرى. وفي أسوأ السيناريوهات — وهو سيناريو منخفض الاحتمال لكنه يظل وارداً — قد تصبح الصورة مفزعة: سيولٌ هادرة تحمل “عناقريب” أهالي أم درمان نحو أسوان. هذا الوصف يعبر بدقة عن ديناميكية اندفاع المياه حين تتجمع قوتها في لحظة منفلتة، بعيداً عن أي مجاز شعري. فقد استقرت سيارات أهالي درنة عند انهيار سدهم الصغير على شرفات الطوابق العليا من العمارات.
وتكمن الخطورة الحقيقية التي تواجه السودان اليوم في غياب المخيال العلمي أكثر من السد بحد ذاته. فالدول تحمي نفسها بالقدرة على “تصور المستقبل” بموازاة القوة المادية. والسيادة — كما يعرف خبراء الاستراتيجية — تبدأ من السيطرة على “الزمن” قبل السيطرة على “المكان”. لا يكفي الركون إلى القول بأن السد آمن بناءً على تطمينات مفعمة بالوعود البراقة، أو تقارير تكنوقراط يقبعون خلف مكاتبهم، يرسمون السيناريوهات استناداً للأماني والرغبات عوضاً عن حسابات الاحتمال.
لقد جاء بركان “هايلي غوبي” ليذكّر بحقيقة بسيطة: الطبيعة ليست غافلة عن ذاتها، إنها في حالة “مخاض مستديم”، متى ما حان أوان طلقها عمّت صرختها الأرجاء. فإذا أراد السودان أن يتجاوز منطق الصدفة، فعليه الانتقال من ثقافة “التواكل القدري” إلى “عقل اليقظة الاحتمالية”.
فبين الخيال والاحتمال تُدار الأزمات، وبينهما تُحمى الدول، وبينهما أيضاً تُكتب النجاة أو تُسطّر الفجيعة. وما بين بركانٍ استيقظ… وسدٍّ ينتظر… يقف السودان أمام سؤال وجودي واحد: هل نكون جاهزين قبل أن يطرق الخطر الباب؟ أم نواصل دفن رؤوسنا في رمال الوهم. تتقاذف مصيرنا المياه الهادرة التي ستكون أمامها محنة الحرب بكل أهوالها منحة لطيفة.
د. محمد عبد الحميد